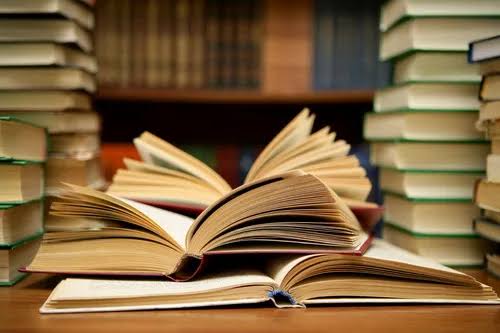بقلم: عماد خالد رحمة_ برلين.
ضمن مسيرة النقد العربي المعاصر، لا يعود ممكناً الاكتفاء بقراءة الرواية بوصفها حكاية تُروى أو بنية لغوية تُحلَّل شكلياً، بل يغدو من الضروري رفع سقف الجدل النقدي، والولوج إلى مناطق أكثر عمقاً، حيث تتشابك النفس والفلسفة والتاريخ واللاوعي في نسيج النص. من هنا، تتبدّى الحاجة إلى تبنّي هيرمينوطيقا تأويلية تحليلية، نفسية وفلسفية في آن، تفكّ رموز الأدوات الأدبية وتعيد مساءلتها، لا بوصفها أدوات جمالية فحسب، بل بوصفها مرايا خفيّة تعكس مأزق الإنسان في صراعه بين جبرية الحياة وحضور جبرية الموت.
إن الرواية، في جوهرها، ليست سرداً للأحداث، بل كتابة للقلق الإنساني في مواجهة الزمن. هي محاولة لترويض الفوضى عبر الحكاية، ولإضفاء معنى على ما يبدو عبثياً. غير أنّ هذا المعنى لا يولد في فراغ، بل يتشكّل داخل شروط تاريخية وثقافية ونفسية محددة. ومن هنا تتباين الرواية الغربية والرواية العربية لا في التقنيات وحدها، بل في الرؤية إلى الوجود ذاته: رؤية تُعلي من إرادة الفعل في الأولى، ورؤية تتنازعها قوى الجبر والاستسلام في الثانية.
في الرواية الغربية، منذ نشأتها الحديثة، نجد حضوراً طاغياً لفكرة الإنسان بوصفه فاعلاً في التاريخ، حتى عندما يُهزم. فالهزيمة هناك ليست قدراً أزلياً، بل نتيجة صراع، وامتحان لإرادة الفرد في مواجهة قوى المجتمع والطبيعة والسلطة. الموت، في هذا السياق، ليس نهاية صامتة، بل ذروة درامية تكشف معنى الحياة أو عبثها. إنه موت يُحاوَر، يُحتجّ عليه، ويُفكَّك بوصفه سؤالاً فلسفياً لا حكماً نهائياً.
أما في كثير من نماذج الرواية العربية، فيتقدّم الموت بوصفه قدراً صامتاً، لا يُناقش بل يُسلَّم له. لا يعود الموت حدثاً درامياً يكشف عن معنى الحياة، بل يتحوّل إلى ظل ثقيل يخيّم على السرد منذ بدايته. الشخصيات لا تموت فقط في نهايات الروايات، بل تموت في الداخل، في قدرتها على الفعل، وفي عجزها عن تحويل الرغبة إلى مشروع. هنا تتجلّى جبرية مزدوجة: جبرية الحياة التي تُفرض بشروطها القاسية من فقر وقمع وتهميش، وجبرية الموت الذي يحضر بوصفه الخاتمة الوحيدة الممكنة لمسار مسدود.
إن هذا الاختلاف لا يمكن رده إلى تقنيات السرد وحدها، بل إلى اختلاف جذري في الذهنية التاريخية. فالعقل العربي، كما تشكّل عبر قرون من الانكسار والاستبداد والاستعمار، حمل في لاوعيه الجمعي نزعة إلى تفسير العالم بمنطق العلل الغيبية والحتميات المغلقة. الحياة تُفهم بوصفها امتحاناً مفروضاً، لا مشروعاً يُصاغ. والزمن لا يُرى كحقل إمكان، بل كمسار محتوم يقود إلى نهاية معلومة. من هنا، تتسرّب الجبرية إلى نسيج الرواية، لا بوصفها فكرة واعية دائماً، بل كمنطق سردي خفي يوجّه الشخصيات نحو المصائر نفسها مهما اختلفت التفاصيل.
في المقابل، تشكّل العقل الغربي في ظل تحوّلات كبرى: الإصلاح الديني، النهضة، التنوير، الثورة الصناعية، وصعود الفرد بوصفه مركز المعنى. هذه التحوّلات لم تلغِ الموت، لكنها نزعت عنه هالته القدرية المطلقة، وجعلته جزءاً من صراع المعنى. لذا نقرأ في الرواية الغربية موتاً يُجادَل، ويُستثمر فلسفياً ونفسياً، ليكشف حدود الحرية وحدود الجبر في آن.
من هنا تبرز أهمية القراءة التأويلية النفسية والفلسفية للرواية العربية، لا بهدف إدانتِها، بل لفهم الشروط التي أنجبت خطابها السردي. فالجبرية التي تسكن كثيراً من نصوصنا ليست اختياراً جمالياً فقط، بل انعكاس لتاريخ طويل من الانكسارات، حيث تراجعت قيمة الفعل أمام سطوة القهر، وحيث صار الصمت فضيلة، والاحتمال بطولة، والاستسلام حكمة مزعومة.
غير أنّ الرواية العربية ليست كتلة واحدة. ففي بعض تجاربها الحديثة، نلمح محاولة للخروج من أسر الجبرية، عبر شخصيات ترفض المصير الجاهز، وتخوض صراعاً مع الواقع ولو انتهت بالهزيمة. في هذه النصوص، لا يعود الموت خاتمة صامتة، بل يصبح سؤالاً مفتوحاً، واحتجاجاً أخيراً على عالم لا يريد أن يتغيّر. هنا تقترب الرواية العربية من أفق إنساني أوسع، حيث الحياة ليست قدراً يُحتمل فقط، بل إمكانية تُصارَع من أجلها.
إن الرواية، في النهاية، ليست مرآة للواقع فحسب، بل مختبر للوعي. وما دامت الرواية العربية تعكس جبرية الحياة وحضور جبرية الموت، فإن ذلك يعني أنّ معركتها الحقيقية ليست تقنية، بل وجودية: معركة لتحرير الخيال من أسر الحتميات، ولإعادة كتابة الإنسان العربي بوصفه كائناً قادراً على الفعل، لا مجرد ضحية لقدر أعمى.
فحين تتحوّل الرواية إلى مساحة لحوار الحياة لا لمناجاة الموت، وحين يصبح السرد فعلاً من أفعال المقاومة الرمزية، لا تسجيلاً للهزيمة، عندها فقط يمكن أن نرى ولادة رواية عربية جديدة: رواية لا تنكر الموت، لكنها ترفض أن يكون هو السيّد الأوحد للحكاية، وتصرّ على أن الحياة، مهما كانت قاسية، تظلّ أحقّ بالسرد من الفناء.