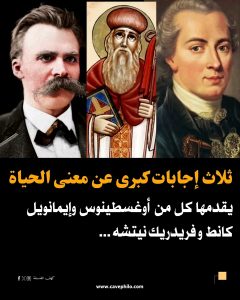الخطأ كطريق للدهشة: كيف يصنع التجريب لغة المصور؟
الضوء، هذا الذي مارس التمرد على الظلام منذ الأزل، وخرج من جوف العتمة مثل الزهرة البرية التي تنتظر أن تفتح أوراقها لكل من تتشبث روحه بالجمال، ليس مجرد شعاع يعبر الهواء بحثًا عن سطحٍ يلامسه أو فيزياء يُقاس بها.
الضوء لمن يقترب منه بقلب سليم، لا بعين المتفرج، يشبه القصيدة التي تختبر نبض الوريد بالشعور قبل أن نختبرها، تضع يدها على قلوبنا قبل أن تهبنا معانيها. وكلما حاول المُصوِر أن يقبض على العالم به في لقطة، فوجئ بأن العالم لا يُسلم نفسه إلا لمن يغامر بالخروج عن المألوف.
ولعل مقولة المُصوِر الأمريكي أنسل ايستون آدامز: “الصورة لا تُلتقط، بل تُصنع.”، تحمل جوهر الأمر. فالتصوير الفوتوغرافي ليس إخضاعًا للواقع، بل خلق جديد، عملية بناء للرؤية التي تُصنع بالروح قبل العدسة. هكذا يولد التجريب من رغبةٍ قديمة ظلت تعيش فينا منذ أشعل الإنسان الأول شرارة النار لإعادة صياغة الرؤية، لا لتغيير الأشياء، بل لاكتشاف ما كان مخفيًا خلف الظاهر المرئي. ففي كل محاولة تحدث، تتسع العين كما لو أنها نافذة فتحت على الدهشةٍ، فتُصبح الصورة سؤالًا عن الإنسان، وعن ذاته، وعن حدود رؤيته، بل وما يجرؤ على رؤيته.
من الأمثلة التي تُجسد عن حق كيف أن التجريب ليس رفاهية، بل فعل ذي رؤية عميق، تجربة المُصوِر الأمريكي يوچين سميث الشهيرة في أوائل السبعينيات مع زوجته في مدينة ميناماتا في اليابان، حيث كان يتعرض سكانها لتسمم جماعي بالزئبق نتيجة التلوث الصناعي من شركة محلية. قرر سميث أن لا يكتفي بتغطية عادية، بل أن يكرس له ثلاث سنوات من التصوير، ليُنتج ما أصبح من أشهر القصص المصورة في تاريخ الصحافة الإنسانية.
من بين آلاف الصور، اختار سميث، بعد تفكير وتجريب طويل، صورة قوية بعنفها الإنساني، عنوانها: Tomoko Uemura in Her Bath (1971) تُظهر الأم وهي تحتضن ابنتها المشوهة كرمز لمعاناة ضحايا التلوث. هذه الصورة لم تلتقط الواقع فقط، بل صنعت رمزًا، وأثارت ضجة عالمية حول قضية بيئية وإنسانية.
العملية عند سميث كانت أعمق من مجرد الضغط على زر الالتقاط، كانت قرارًا أخلاقيًا، ورؤية إنسانية، بل وتجريبًا بصريًا، اختار فيه (الإطار/ الإضاءة/ اللحظة)، حتى ترتبط الصورة بوعي المُتلقِي وتُثير فيه الأسئلة، لا فقط الإثارة للبصرية.
هذا بالضبط ما يعنيه التجريب. ليس مجرد حيلة تقنية، أو محاولة لإعادة ترتيب العناصر بطريقة أخرى، أو اللعب بزوايا العدسة وسرعة الغالق وجرعات الضوء. بل هو لمن يقترب منه حقًّا ويضع عينه على حافة الاحتمال ثم يضغط زر الالتقاط كما لو أنه يُطلق سهمًا من عمق روحه، ويدرك، امتحانٌ للوجود نفسه. فكما يقول آدامز أيضًا: “لا قيمة للدقة التقنية في الصورة إذا كانت الفكرة ضبابية.”
أي أن الصورة التي تخلو من الرؤية، وإن بلغت ذروة الدقة، تبقى خالية من الوعي، معطوبة من الداخل.
إن التجريب هو اللحظة التي يختبر فيها المُصوِر قدرته على رؤية ما لا يُرى، وجرأته على مساءلة ما اعتاده الناس حتى صار كالهواء: مألوفًا، شفافًا، لا يثير سؤالًا. إنه ببساطة، تلك المنطقة الرمادية التي يلتقي فيها الضوء بالشعور، والواقع بالخيال، والمشهد الماثل بما لم يقع بعده. هو الصلاة التي تُؤدَى، لا لطلب النجاة، بل لاستدعاء معنى جديد للعالم.
ففي كل تجربة، تُلقى الروح في المجهول كما يُلقى حجرٌ في بئرٍ عميقة لعل صدى ارتطامه يكشف لنا عمق المياه، ولأن كل محاولة فنية هي محاولة لفهم أنفسنا، فإن التجريب يصبح طريقًا لامتحان هذا الفهم، وتوسيع حدوده، وتعرية النقاط التي نتجنب النظر إليها داخلنا.
وإلا فلماذا التجريب ضرورة مُلحة لكل ممارس أو مهتم بفن التصوير الفوتوغرافي؟
في رأيي لأن المُصوِر الذي لا يُجرب، يُشبه كاتبًا اكتفي بتدوين الجمل التي سمعها من غيره؛ ربما بها يخرج نصه لفضاء الوجود صحيحًا نحوياً، لكنه يظل بلا حرارة، بلا ارتعاشة تُعلن أن صاحبها هنا، حاضر، يرى بطريقة لا تشبه أحدًا. فالتجريب ليس ترفًا، ولا نزوة فنية يتسلى بها المُصوِر حين يضجر من التكرار. إنه ما يجعل الممارس فنانًا لا مُقلدًا، وما يمنحه القدرة على اكتشاف لغته الخاصة في عالمٍ يموج بالصور حتى صارت ألوان السماء نفسها مزدحمة بأضواء الآخرين.
هو فعل مقاومة ولا شك. يحارب الكسل البصري، والانصياع للقواعد، ولتلك السكينة الزائفة التي تمنحها الصور المكررة. إن العالم يتغير، وكذلك الضوء، والإنسان نفسه يتقلب من حال إلى حال. فكيف يمكن لصاحب كاميرا أن يظل ثابتًا في عالمٍ لا يكف عن الحركة؟
ولأن هنري كارتييه-بريسون رائد فن تصوير الشارع كان يرى أن: “التصوير هو أن تدرك جوهر الحدث وأهميته في جزء ضئيل من الثانية.”، هذه الجملة تكاد تكون مرآةً لما نقوله: إن الضغط على زر الالتقاط ليس فعلاً ميكانيكيًا؛ إنه التقاء وميض الحدث بقرار الروح في لحظة لا تتكرر.
إن التجريب ليس فقط ضرورة فنية، بل ضرورة وجودية، فمن دون المخاطرة والفضول لن يكون للمُصوِر الفوتوغرافي أي أثر حقيقي يُذكر. فأجمل ما في هذا الأمر أنه يعيد الصداقة القديمة بين الفنان والخطأ في عالمٍ أصبح يُقدس الكمال.
لذلك أقول لكل ممارس: “اخطئ كما تشاء، فالفوضى قد تكون بوابةً للدهشة”.
فكم من صورة عظيمة خرجت من انكسار ضوء غير مقصود، أو اهتزاز يد، أو انعكاس لم يُحسب له حساب؟ الخطأ في التصوير ليس عيبًا بل احتمال يقود صاحبه نحو بُعدٍ جديد من دون أن ينتبه، كما لو أنه يرد الضوء إلى حريته الأولى. لا يفرض عليه شكلًا مسبقًا، ولا يسجنه داخل قوالب النجاح المضمون. إنه يُنصت للمطالبة بالحق في التشكيل، وهنا يتكشف السر حين يكف المُصوِر عن فرض السيطرة وإحكامها.
البعض يظن أن التصوير الفوتوغرافي حرفة بصرية ولا شيء غير ذلك، بينما الحقيقة تكمن في كل تجربة جديدة في الضوء، والتي تعادل المحاولة فيها درسًا في الفلسفة.
فحين يحاول المُصوِر، ويُطلق سراح نفسه من الترويض إلى عنان التجريب، فهو في الواقع يسأل، وأسئلته هذه ليست ترفًا فكريًا. إنها جزء أصيل من التجربة الفوتوغرافية. فالممارس حين يعيد ترتيب احتمالات المشهد، لا يعيد ترتيب العناصر فحسب، بل يعيد ترتيب علاقته بالعالم. والتجريب هنا يصبح طريقة لفهم الذات، وطريقًا لمعرفة كيف نرى ولماذا نرى وما الذي نرفض رؤيته أصلًا.
فالممارس الذي يُجرب بصدق، سيكتشف أن كل محاولة جديدة هي فصلٌ جديد في سيرته الذاتية، وكلما ازدادت جرأته في التجريب، ازدادت قدرته على اكتشاف ورؤية ذاته التي كانت تختبئ عن قصد منه.
ففي عصرٍ تتنافس فيه التقنيات الحديثة على أفضلية التربع فوق عرش الوجود، قد يُخدع الممارس بالاعتقاد أن التجريب يعني امتلاك الأدوات والتكنولوجيا الأحدث. لكن الحقيقة أن هذه الأمور، مهما تطورت، لن تهب المُصوِر عينًا جديدة. التجريب ليس تحديثًا للعدسات، بل تحديثًا للعقل.
المهارة التقنية بالتأكيد مطلوبة، لكنها تشبه القاموس: وجوده لا يصنع الشاعر، لكنه يمنحه مفاتيح ليعيد ترتيب اللغة كما يشاء.
والدليل، أن أكثر الصور تأثيرًا لم تُلتقط بكاميرات فاخرة، بل بعينٍ كانت أكثر جرأة من أي عدسة. فبينما يركض الناس خلف الجودة، يركض التجريب خلف المعنى. لذلك هو ليس لحظة عابرة، بل فعلٌ تتسع دلالاته مع الزمن لإعادة كتابته من جديد. فلا تُصدقوا أن الصورة تتجمد بعد لحظتها الأولى؛ الضوء يستحق أكثر من أن يُختصر في قواعد ثابتة، والوعي أعمق من أن يُختزل في لقطات مكررة.
كل ممارس لهذا الفن الأخاذ يجب عليه أن يدرك هذا جيداً، ما إن يصل إلى منطقة يظن أنها ذروة اكتشافه، حتى يكتشف أنها ليست إلا بداية جديدة. هكذا يعمل التجريب، بابًا يفتح بابًا، احتمالٌ يجر احتمالاً آخر للوجود الذي يُعاد ترتيبه مع كل لقطة.
في النهاية، التجريب مع الضوء في التصوير الفوتوغرافي ليس منهجًا فنيًا فقط بقدر ما هو موقف من العالم. إعلانٌ بأن الممارس لا يقبل أن يكون مجرد شاهد، بل فاعلًا في إعادة تشكيل الرؤية، والقبض على لحظةٍ لا تُمنح إلا لمن يغامر بالخروج من المألوف.
والتصوير، منذ بداياته، محاولة إنسانية لفهم ما يجعل حياتنا تستحق أن تُرى. والتجريب، في قلب هذا كله، هو نبضُ المغامرة؛ الشجاعة التي تجعلنا نضغط على زر الالتقاط ونحن نعرف أن ما سنحصل عليه قد لا يكون كاملًا، لكنه سيكون صادقًا، ومن الصدق وحده تُولد الصورة التي لا تنمحي.