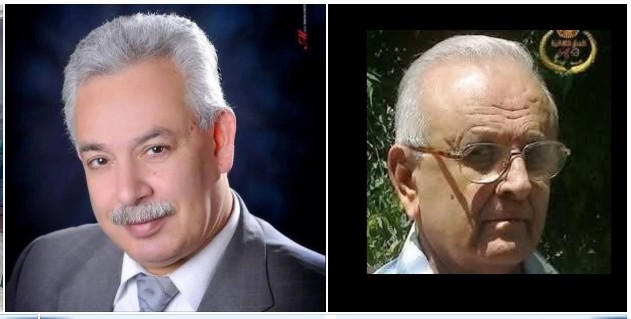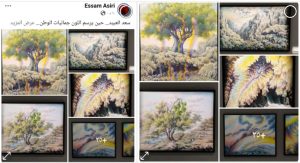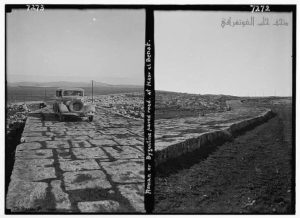دراسة نقديّة تحليلية موسّعة
لقصيدة «موجَزٌ للسِّيرةِ التالِفَة» للشاعر السوري أحمد يوسف داود:
بقلم : عماد خالد رحمة _ برلين.
تقف قصيدة «موجَزٌ للسيرة التالفة» للشاعر السوري أحمد يوسف داود كفضاء شعري متعدّد المستويات، يمتزج فيه الوجودي بالرمزي، والوجداني بالمعرفي، والوطني بالإنساني. إنّ النص لا يكتفي بإيصال إحساس أو تجربة شخصية، بل يفتح أفقاً تأويلياً واسعاً يتيح للقارئ الغوص في أعماق الذات، واستكشاف تناقضاتها، وانكساراتها، وصراعاتها مع الزمن والذاكرة والتاريخ.
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الهيرمينوطيقي التأويلي لفهم مستويات الدلالة المضمرة في النص، وعلى التحليل الأسلوبي والرمزي لتفكيك اللغة والصور الشعرية التي تحمل توتّراً داخلياً وإيقاعاً دالاً على صراع الشاعر مع ذاته والعالم المحيط به. كما تستند الدراسة إلى السيميائيات وفق نموذج غريماس لاستخراج محاور الأدوار (الفاعل، المفعول، المرسل، المتلقي، المعين، المعوق) وفهم البنية الدلالية للنص، وإلى التحليل النفسي والفلسفي والديني للكشف عن التوترات الداخلية وعلاقة الشاعر بالوجود والحياة والهويات المتنافرة في سيرته التالفة.
من خلال هذه المقاربة المتعددة المستويات، تصبح القصيدة نصّاً معرفياً حياً، تتشابك فيه عناصر القلق، والفقد، والخيبة، والبحث عن الذات، لتقدّم تجربة شعرية تتخطى حدود اللغة إلى أفق وجودي وإنساني شامل.
إنّ قراءة قصيدة «موجزٌ للسيرة التالفة» تستدعي بالضرورة دخولاً هيرمينوطيقياً متأنّياً، إذ لا تقدّم القصيدة نفسها بوصفها بنية لغوية فحسب، بل بوصفها اعترافاً وجودياً مهشَّماً، وسيرة ذاتية محطّمة في بنية شعرية عليا تتأرجح بين التناقض والمعنى، وبين الإشراق والانطفاء. من البيت الأوّل يضعنا الشاعر أمام توتّر جوهري بين الأنا والوهم، بين الرغبة في الإفلات من قبضة القدر ومناورة القوى الغامضة التي تتسلّل إلى مسار الوعي. إذ يقول:
«ما قلتُ للأوهام دوري بي على أرقٍ/ولفيني ببعضٍ من غباركِ/ثم خليني وغيبي!»
هنا يتمظهر الفعل الوجودي بوصفه رفضاً وتأففاً وتبرّماً، ومع ذلك فإنّ الأوهام – على خلاف إرادة الشاعر – تتقدّم كقوة فاعلة مستقلة، وهذا ما يعيدنا إلى هيرمينوطيقا الإرادة واللاوعي الذي يرى أن الإنسان يصنع سرديته من ثغراته، وأنّ ما ينكره هو ما يتسلّل إلى حكاية حياته.
فالقصيدة تُفتتح أصلاً على توتّر أنطولوجي: الشاعر لم يطلب من الأوهام شيئاً، ولكنها فَعَلت، وكأنّ الشاعر يريد، لكنه لا يريد أن يكون هو الراغب. تتجلى هنا الازدواجية التي تحدّث عنها العديد من النقاد الغربيين: الذات التي تهرب من شيء هي غالباً الذات التي تتعلّق به سرّاً. وهذا الانفصام بين الإرادة المعلنة والرغبة الخفية يشكّل محرّك القصيدة على امتدادها.
حين ينتقل الشاعر إلى قوله:
«وأعجبُ كيف جرجرني حصان ضلالتي في ظلّها/بين الطفولة والمشييب!»
نجد أنفسنا أمام رمز مركزي: الحصان.
ليس حصاناً مادياً بل حصاناً دلالياً، أقرب إلى حصان شكسبير في «ماكبث» أو حصان نيتشه الذي بكى عند انهياره؛ حصانٌ هو القدر، الغريزة، القوة العمياء التي تجرّ الذات دون أن تستأذنها، على خطّ زمني بين طفولةٍ ليست بريئة، ومشييبٍ لم ينضج.
هذا الانزلاق الوجودي بين الزمنين يذكّر بنظرية باشلار في «جماليات الزمن الداخلي»؛ فالزمن ليس تاريخاً، بل تجربة شعورية تعيد تشكيل نفسها باستمرار.
وحين يقول الشاعر أحمد يوسف داود:
«مالي أطيل رهان قلبي كالسقيم على الهلاك/وأبدع الآلام لي كي لا أملّ من الأسى؟»
فإنه يفتح نافذة على البنية النفسية للقصيدة:
ثمة نزوع نحو التعذيب الذاتي، نوع من «اللذة السادية المعكوسة» التي تحدّث عنها فرويد:
الرغبة في الألم بوصفه تأكيداً للوجود.
القلب هنا ليس عضواً بيولوجياً، بل «ذاتٌ ثانية» تراهن على الهلاك كي تستشعر الحياة.
وبهذا يكون النصّ قريباً من فكر شوبنهاور حيث الألم هو الوقود العميق للوعي.
وفي قوله:
«هذا أنا وعلى فمي ظمأ الحياة وإرث أسئلة… وطعم آثام الضلالة والهروب!»
يتشكّل جوهر فلسفة الشاعر: الظمأ، الأسئلة، الآثام، الهروب.
هذه المفردات ليست مجرّد كلمات، بل حقول دلالية تصنع بنية كاملة تقود النص نحو تيمة «السيرة التالفة».
إنّ الشاعر يقدّم ذاته بوصفها ذاتاً مُنهَكة، مثقلة بأسئلة الوجود، وناقلة لخطايا لم ترتكبها فعلاً بل ورثتها عبر التاريخ.
وهذا يعيد إلى أذهاننا مفهوم هايدغر عن «الدازاين الساقط»؛ الإنسان الذي يجد نفسه في عالم لم يختره، محملاً بتراث لا يملك أن يتنفّس خارجه.
التحوّل الدراماتيكي يلتحم في المقطع الثالث:
«سقطت رهانات البلاغة… فارتدى القتلى فصاحة قاتليهم واستقاموا»
إنّ هذا المشهد من أعمق ما كتب أحمد يوسف داود، فمن خلال استعارة واحدة ينسف الخطاب السياسي والأخلاقي والاجتماعي.
«ارتدى القتلى فصاحة قاتليهم»:
هذه الصورة تُحيل فوراً إلى ميشيل فوكو وفكرته عن الخطاب والقوة؛ فالخطاب هو ما يمنح الشرعيّة للعنف، وهو ما يجعل المقتول يكرر كلام قاتله وكأنه الحقيقة.
إنها صورة قاتمة للوطن، حيث تتحوّل البلاغة إلى أداة قتل، ويحمل الضحية خطاب الجلاد عن قناعة أو قهر.
وهنا يصل النص إلى أعلى درجات السياسي والوطني دون أن يذكر السياسة تصريحاً.
ثم يتابع:
«والشهود تفرقوا شيعاً كأذناب الثعالب… ثم في التهليل ناموا!»
هنا يرتفع المستوى الرمزي:
«ذيول الثعالب» هي الانتهازية، والغدر، وتحويل الحقيقة إلى مسرح عبث.
أما «التهليل» فهو نقد ساخر للتحوّل الديني إلى قناع يغطّي الجريمة.
إن القصيدة هنا لا تنقد السياسة فقط، بل تنتقد العقل الجمعي القادر على النوم على جريمة مكتملة، كما لو كانت نشيداً مفرحاً.
وهذا يقودنا إلى إريك فروم:
«الهروب من الحرية» بوصفه سلوكاً نفسياً جماعياً.
وعندما يقول:
«وأنا الذي ما كنت في القتلى ولا في القاتلين… ولم أكن بين الشهود»
فإنه يعلن موقعه الوجودي:
هو الغريب، الخارج عن المشهد، الواقف على حافة التاريخ، العابر بلا انتماء.
هذه الصورة الوجودية تتقاطع مع «الغريب» لألبير كامو:
إنسان يرفض أن يكون جزءاً من القتل، ولكن لا يجد مكاناً في الحياة.
وحين يصل إلى:
«شُكراً لقلبي قد تصيّد ما تصيّد… ولم يكن في الكنز إلا صفعة بحذاء كاذبة لعوب!»
نصل إلى القمة الرمزية.
القلب صيّاد، لكنه اصطاد الوهم.
الكنز، الذي بدا آخر الأماني، لم يكن سوى صفعة.
إنها قراءة نيتشوية لحقيقة القيم:
كل قيمة عظيمة يخفي خلفها خداع أو «كذبٌ ميتافيزيقي» كما يقول نيتشه.
القلب في القصيدة ليس بريئاً، لكنه ليس مجرماً؛ إنه كائن يجاهد لفهم العالم، وينتهي دائماً إلى الخيبة.
ويصل الشاعر إلى خاتمة فعليّة:
«شكراً لقلبي… لم يشر يوماً إلى عار الحكاية، كنت وحدي غافلاً عنّي وتلهو بي تفاصيل الحكاية كالغريب»
هنا يحدث اكتمال الحلقة الوجودية.
القلب لم يكن خائناً، بل كان مرآة صامتة.
العار ليس في القلب، بل في «السردية» نفسها:
سيرة تائهة، تالفة، غامضة، تتلاعب بالشاعر كما تتلاعب الريح بظلّ غريب في الدروب.
تطبيق منهج غريماس السيميائي (المربّع العُمَقي ومحاور الأدوار)
١_ الفاعل: الشاعر / الأنا
٢_ الموضوع: الحقيقة – النجاة – الوعي – الخلاص
٣_ المرسل: الألم – التجربة – القدر – التاريخ
٤_ المرسل إليه: الشاعر ذاته (بوصفه ذاتاً تبحث عن تبرير وجودها)
٥_ المساعد : القلب، الأسئلة، الوعي، الندم
٦_ المعيق: الوهم، الخيبة، البلاغة الزائفة، المجتمع، القتلة، القدر
بهذه القراءة يتضح أنّ الشاعر يخوض رحلة سيميائية للفشل:
كلّ ما يساعده ضعيف، وكلّ ما يعيقه قوي.
لذا تصبح السيرة تالفة، لأنّ البنية السيميائية للوجود مختلّة أصلاً.
_قراءة في الأنساق المعرفية للنص:
القصيدة تقوم على ثلاثة أنساق واضحة:
- نسق وجودي: سؤال الذات، معنى الألم، مصير الإنسان.
- نسق سياسي – اجتماعي: سقوط القيم، انقلاب الأدوار، تمجيد الجلّاد.
- نسق روحي – أخلاقي: الضلالة، الهروب، الصفعة، القلب الذي لا يخون.
هذه الأنساق تشكّل شبكة معرفية تتراوح بين الميتافيزيقي واليومي، بين واقع الحرب ومحارق الروح، بين سؤال الأخلاق وسؤال المصير.
خلاصة تحليلية:
إنّ قصيدة «موجز للسيرة التالفة» ليست مجرّد رثاء ذاتي، ولا بياناً سياسياً، ولا صرخة وجودية، بل هي مزيج متماسك من هذه كلها.
إنها شهادة شاعر على زمن يفقد الحقيقة، وعلى قلبٍ يفتّش في الخراب عن معنى، وعلى سيرة يحاول أن يصوغها رغم أنها تُكتب ضده لا بيده.
إنها قصيدة قلبٍ محاصرٍ بثلاثة أعداء:
الوهم، التاريخ، واللغة.
ومع ذلك ينجو… لأنّه يعترف.
لقد كشفت الدراسة النقدية التحليلية الموسّعة لقصيدة «موجَز للسيرة التالفة» عن مدى تعقيد النص وعمقه الدلالي، إذ يجمع بين البعد النفسي والفلسفي والوطني، ويقدّم رؤية شعرية لمفارقات الوجود وتجارب الذات الإنسانية في مواجهة التاريخ والواقع والذات.
أظهرت القراءة الهيرمينوطيقية أنّ النص ليس سرداً مباشراً للأحداث، بل هو شبكة من الرموز والتجارب والمشاهد التي تستدعي التأويل، فيما أبرز التحليل الأسلوبي والرمزي قدرة اللغة على التعبير عن توترات داخلية، وعن صراع الذات مع الزمن والفقد والهويات المتضاربة. كما أتاح تطبيق منهج غريماس السيميائي استخراج محاور الأدوار داخل النص، مما كشف عن البنية المعرفية والوجودية للقصيدة، حيث الفاعل، والمفعول، والمرسل، والمتلقي، كلهم يتصارعون داخل سياق شعري غني بالمعاني.
في النهاية، تؤكد هذه الدراسة أن قصيدة أحمد يوسف داود ليست مجرد سرد شخصي، بل نصّ شعري حيوي يتفاعل مع القارئ، ويستثير أسئلته حول الذات، والمعنى، والخسارة، والبحث عن الحقيقة. إنها شهادة شعرية على هشاشة الوجود، وثراء اللغة، وعمق التفكير الإنساني، وامتداد السيرة إلى ما هو أبعد من الفرد ليشمل الوطن والتاريخ والروح.
ففي فضاءٍ يتجاور فيه الضوء بالعتمة، وتتداخل فيه نبضات الذات مع طبقات التاريخ والذاكرة، تقف قصيدة «موجَزٌ للسِّيرةِ التالِفَة» للشاعر السوري أحمد يوسف داود**
بوصفها نصّاً لا يُقرأ من سطحه، بل يُصغى إليه من أعماقه. فهي قصيدة مشغولة بقلق المعنى وارتعاش الروح، تُخفي أكثر ممّا تُظهر، وتُومئ أكثر ممّا تُصرّح، وتستدعي قارئاً يمتلك أدوات الحفر تحت الجلد الشعري بحثاً عن ذلك السرّ الذي يتوارى عند تخوم الرمز. من هنا، تأتي هذه الدراسة لتتوسّل المنهج الهيرمينوطيقي التأويلي، وتستنطق البنية الأسلوبية، وتكشف البعد الرمزي والديني والنفسي، وتُحلّل البنية السيميائية وفق منهج غريماس وما يتيحه من خرائط دلالية تكشف العلاقات العميقة بين الدوالّ والمدلولات.
إنّ الوقوف أمام هذا النص ليس قراءة جمالية فحسب، بل هو عبور عبر شبكة معقدة من العلامات والإشارات، حيث يتجاور في القصيدة صوت الذات الجريحة مع الذاكرة الجمعية، وينبعث من خلف الكلمات وطنٌ يتأرجح بين الحضور والغياب. لذا، حاولت هذه الدراسة أن تتوغّل في نسيج الخطاب الشعري، وأن تكشف نبضه الخفي، وتوتره الداخلي، وعناصره الجمالية والبلاغية التي شكّلت بنيته، لتفتح بذلك أفقاً جديداً لفهم التجربة الشعرية للشاعر أحمد يوسف داود فهماً يتجاوز القراءة الانطباعية إلى قراءة معرفية معمّقة.
بعد هذا الغوص الطويل في تضاريس النص الشعري للشاعر أحمد يوسف داود ، يتبيّن لنا أن القصيدة ليست مجرد بنية لغوية مزيّنة بالصور، بل فضاء دلالي تتداخل فيه الأصوات والرموز والأسئلة الكبرى حول الهوية والذاكرة والإنسان والقداسة والجسد. وقد كشف المنهج الهيرمينوطيقي، إلى جانب الأساليب الرمزية والسيميائية، عن عمقٍٍ نفسي ووجودي لا يظهر للقارئ من القراءة الأولى، بل يتطلب جهداً تأويلياً يتعامل مع القصيدة بوصفها كياناً حيّاً نابضاً بالتحوّل.
لقد تبيّن أنّ النص يؤسّس لعلاقة جدلية بين الذات والعالم، بين الألم والخلاص، بين الجرح والكتابة، وأنه يستخدم شبكة من الرموز والمقابلات لتشييد معنى يتجاوز حدود المباشر إلى فضاءات التأويل الرحبة. كما أظهر التحليل السيميائي وفق نموذج غريماس قدرة القصيدة على إنتاج طاقات سردية ودلالية رغم بنائها الغنائي، مما يجعلها نصاً قادراً على احتضان تعدّد القراءات.
وهكذا، تبرهن تجربة
الشاعر أحمد يوسف داود على أنّ الشعر ما يزال قادراً على أن يكون مرآةً للروح، ونداءً للباطن، وفضاءً تتقاطع فيه الجمالية مع المعرفة، والوجدان مع السيمياء، في نصّ لا ينتهي عند حدّ، بل يظلّ مفتوحاً على احتمالات القراءة وإعادة التأويل.
نص القصيدة ؛
موجَزٌ للسِّيرةِ التالِفةْ!.
الشاعر أحمد يوسف داود
ما قلتُ للأوْهامِ دوري بي على أرَقٍ
ولُفّيني ببعضٍ منْ غُباركِ..
ثم خلّيني وغيبي!.
لكنّها فَعلتْ، وأعجَبُ كيف جَرجَرني
حِصانُ ضَلالتي في ظِلِّها
بين الطُّفولةِ والمَشيبِ!.
مالي أُطيلُ رِهانَ قلبي كالسّقيمِ على الهَلاكِ..
وأُبدِعُ الآلامَ لي كي لاأمَلّ منَ الأسى
وأقودُ نجمَ حِكايتي نحوَ المَغيبِ؟!.
هذا أنا وعلى فَمي ظَمأُ الحَياةِ وإرثُ أسئِلةٍ
وأقداحُ الكلامِ عنِ السَّرابِ
وطَعمُ آثامِ الضّلالةِ والهُروبِ!.
سقطَت رِهاناتُ البَلاغةِ فارتَدى القَتلى
فَصاحةَ قاتليهم واستَقاموا..
والشُّهودُ تفرَّقوا شِيَعاً كأذنابِ الثعالبِ
ثمّ في التّهليلِ ناموا!.
وأنا الذي ماكُنتُ في القََتلى ولا في القاتلينَ..
ولم أكنْ بينَ الشُّهودِ..
علامَ تأتيني الحياةُ أو الحِيادُ؟!..
وكيفَ لايَلهو بما أَثِقُ اللِّئامُ؟!.
شُكراً لِقَلبي قد تَصيَّدَ ما تَصيّدَ من فُتاتٍ
قيلَ فيهِ: (جَواهِرُ الكَنزِ الأخيرِ)..
ولم يكن في الكَنزِ إلّا صَفعةٌ
بحِذاءِ كاذِبةٍ لَعوبِ!.
شُكراً لقَلبي لم يَقلْ لي إنّني خَلقٌ غَريبٌ..
لم يُشرْ يوماً إلى عارِ الحِكايةِ..
كنتُ وَحدي غافِلاً عنّي
وتَلهو بي تَفاصيلُ الحِكايةِ كالغَريبِ!.
–‐—-‐———-‐——