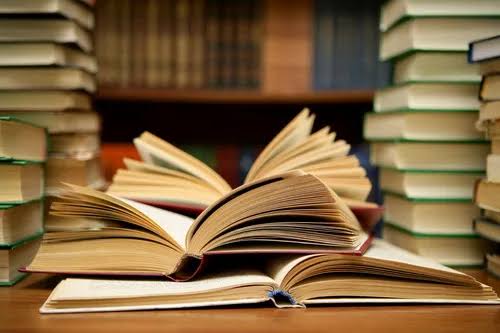بقلم: عماد خالد رحمة _ برلين.
منذ أن ألقى أفلاطون ظلَّه الأول على كهف الوجود، والفلسفة الغربية تسير وفي يدها مشعلُ “الحقيقة”، لا بوصفها حادثة عابرة، بل باعتبارها كيانًا ساميًا، متعاليًا، سابقًا على التجربة، أعلى من الحسّ، وأصفى من اللغة. هكذا وُلد ما اصطلح على تسميته بـ“المدلول المتعالي”: ذلك المعنى الذي يُفترض أنّه حاضر في ذاته، مكتفٍ بذاته، لا يحتاج إلى علامةٍ تدلّ عليه بقدر ما تحتاج العلامات إليه كي تستمدّ شرعيتها.
في هذا الأفق، شُيّدت الميتافيزيقا الكبرى: المبدأ الأول، الصورة، الهيولى، الغاية، الأزل، الإله… كيانات لا تُرى ولا تُلمس، لكنها تُعطى مقام السيادة، ويُطلب من الفكر أن يصعد إليها كما يصعد العابد إلى محرابه. إنّها مفاهيم وُضعت في مركز النظام المعرفي، وأُحاطت بهالة من القداسة العقلية، حتى بدا أن الحقيقة لا تكون حقيقة إلا إذا كانت متعالية على العالم، متسامية على الزمان، منزّهة عن التغيّر.
غير أنّ هذه السيادة لم تكن بلا ثمن. فلكي يُحافَظ على “الحقيقة السامية”، كان لا بدّ من إخضاع اللغة لدورها التمثيلي الصامت: أن تكون مجرّد مرآة تعكس ما هو موجود سلفًا في عالم المعاني الخالصة. وهكذا رُسّخت المقابلة الكلاسيكية بين الدال والمدلول، بين اللفظ والمعنى، على نحو يجعل المدلول سيّدًا والدال تابعًا، يجعل المعنى حاضرًا قبل الكلمة، والكلمة ظلًّا لذلك الحضور.
لكن، حين جاء جاك دريدا، لم يأتِ بسهمٍ يوجَّه إلى هدف واحد، بل جاء بزلازل تهزّ أساس البناء كله. لم يسأل: ما الحقيقة؟ بل سأل: كيف تعمل اللغة حين تدّعي أنها تقول الحقيقة؟ ومن هنا انقلب السؤال من البحث عن المدلول المتعالي إلى مساءلة شروط إمكان هذا المدلول ذاته.
رأى دريدا أنّ الفلسفة، منذ أفلاطون حتى هايدغر، كانت أسيرة حلم واحد: حلم الحضور. أن يكون المعنى حاضرًا لذاته، متطابقًا مع نفسه، شفافًا أمام الوعي. وهذا الحلم هو ما غذّى فكرة “المدلول المتعالي”: معنى نهائي، ثابت، لا يختلف، لا يتأجّل، لا يحتاج إلى غيره لكي يكون.
غير أنّ التفكيك جاء ليقول: إنّ هذا الحضور المزعوم ليس سوى وهم ميتافيزيقي. فالمعنى لا يُعطى دفعة واحدة، ولا يحضر كاملًا في لحظة واحدة، بل يتشكّل داخل شبكة من الاختلافات، داخل حركة لا تهدأ من الإرجاء والتأجيل. وهنا يولد مفهوم “الأثر”.
الأثر، عند دريدا، ليس بقايا شيء كان حاضرًا ثم غاب، بل هو بنية المعنى ذاته. كلّ معنى يحمل في داخله آثار معانٍ أخرى، غائبة، مؤجَّلة، مختلفة. ما من كلمة تقول ما تقول وحدها؛ إنّها تقول ما تقول لأنّها ليست كلمات أخرى. إنّها معنى بالاختلاف، لا بالحضور. ولذلك فإنّ الأثر يمحو، في آنٍ واحد، وهم الحضور الذاتي ووهم الأصل الخالص. فلا أصل إلا وهو مشوب، ولا حضور إلا وهو مثقوب بالغياب.
بهذا المعنى، لا يعود المدلول سيّدًا على الدال، ولا المعنى سابقًا على الكلمة. بل المعنى يولد داخل الكلمة، ويتحوّل معها، وينزلق منها إلى غيرها. ومن هنا رفض دريدا أسبقية المدلول على الدال كما صاغها فرديناند دي سوسير، لأنّ هذه الأسبقية تفترض وجود مفاهيم “حاضرة” في ذاتها، مستقلة عن اللغة، واللغة ليست إلا لباسًا خارجيًا لها. التفكيك يعلن العكس: لا معنى خارج اللغة، ولا حضور قبل العلامة.
لكن التفكيك لا يكتفي بهدم الأصنام الميتافيزيقية، بل يكشف أيضًا مفارقة عميقة: إنّ الفلسفة التي أرادت الوصول إلى الحضور عبر اللغة، وجدت نفسها محاصَرة باللغة ذاتها. اللغة، التي استُخدمت أداةً لبلوغ الحقيقة المتعالية، هي نفسها التي تمنع هذا البلوغ. فهي لا تعطي المعنى صافياً، بل عبر سلسلة من العلامات التي تحيل إلى علامات أخرى، في لعبة لا نهائية من الإحالة.
وهكذا يتحوّل المدلول المتعالي من حقيقة سامية إلى وهمٍ منتج: وهم ضروري للفلسفة كي تبني أنساقها، لكنه وهم يجب أن يُفضَح كي تتحرّر الفلسفة من ادّعاء الامتلاك النهائي للحقيقة. التفكيك لا يقول: لا معنى، بل يقول: لا معنى نهائي، لا حضور مكتمل، لا مركز ثابت.
وفي مقابل الحضور الذاتي، يقيم التفكيك أخلاقًا جديدة للفكر: أخلاق الانفتاح، والشكّ، والقبول بالاختلاف. فالمعنى ليس ملكًا لأحد، ولا يُختَزل في تأويل واحد، ولا يُغلق في صيغة أخيرة. إنّه رحلة، لا محطة؛ حركة، لا سكون؛ سؤال، لا جوابًا نهائيًا.
من هنا، يصبح “المدلول المتعالي” شاهدًا على شهوة الفلسفة القديمة إلى الاطمئنان، بينما يكشف التفكيك قلق المعنى بوصفه شرطًا للحرية. فالمعنى الذي يطمئن أكثر مما ينبغي يتحوّل إلى سلطة، والسلطة تبدأ دائمًا من ادّعاء الحضور الكامل.
إنّ ما يقدّمه دريدا ليس هدمًا عبثيًا، بل تحريرًا للعقل من وهم الامتلاك، وتحريرًا للغة من دور الخادمة للميتافيزيقا. فحين نعترف بأنّ المعنى أثر، وأنّ الحضور وهمٌ منتج، نكون قد انتقلنا من عبادة الحقيقة إلى مساءلتها، ومن تقديس المعنى إلى مساءلة شروط ولادته.
وهكذا، بين التفكيكية التقويضية والحضور الذاتي، لا يقف الفكر على تخوم الهدم، بل على أعتاب إمكان جديد: إمكان أن نفكّر دون أوثان، وأن نقرأ دون يقينٍ متعجّل، وأن نعيش المعنى بوصفه أفقًا مفتوحًا، لا قفصًا ميتافيزيقيًا مغلقًا.