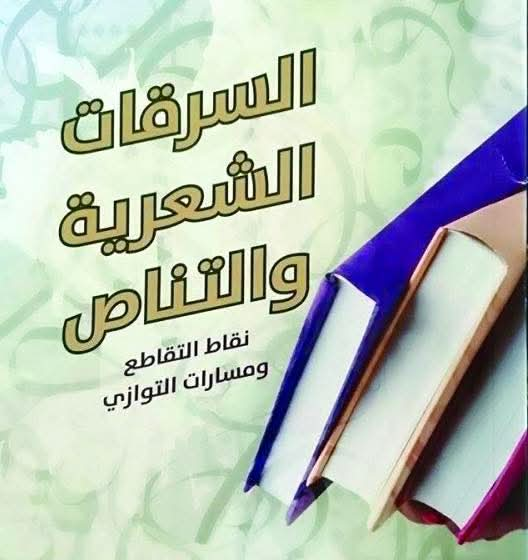بقلم الشاعر عبد الواسع السقاف
لم يعد الخلط بين التناص والسرقة الأدبية التباسًا بريئًا في المشهد الشعري العربي، بل غدا – في كثير من الأحيان – ممارسة واعية تُستخدم لتبرير الفشل وسرقة الإبداع، أو لنزع المسؤولية الأخلاقية عن نصوص لا تمتلك من الإبداع سوى حسن التمويه. وقد لمسنا ذلك في مناسبات كثيرة؛ فكلما كُشف نصٌّ مستعار، ارتفعت اللافتة الجاهزة: «هذا تناص».
في الأصل، التناص مفهوم نقدي حديث صاغته جوليا كريستيفا، يقوم على فكرة أن أي نص جديد يولد من تفاعلٍ عميق مع نصوص سابقة، لا باستنساخها، بل بامتصاصها وتحويلها إلى دلالة جديدة. غير أن هذا التعريف كثيرًا ما يُساء فهمه؛ فالتناص ليس نقلًا، ولا محاكاة سطحية، بل إعادة بناء تُفضي إلى معنى مغاير، وتضع النص الجديد في حوار حيّ مع التراث والذاكرة الثقافية.
غير أن هذا المفهوم، حين خرج من عباءة النقد إلى منصات النشر السريع، فقد دقته وميزانه، وتحول إلى مصطلح فضفاض يُلصق بأي تشابه كيفما اتفق. فاستدعاء الرموز الدينية، أو الأسطورية، أو التاريخية – كما في توظيف قصة النبي أيوب عليه السلام عند بدر شاكر السياب في «سفر أيوب» بنجاح – لا يُعد تناصًا إلا حين يُنتج رؤية جديدة، لا حين يكتفي بإعادة العبارة أو الصورة كما وردت في الأصل.والأنكى من ذلك أن السرقة الأدبية، مهما حاول أصحابها تغليفها بلغة نقدية حديثة، تبقى فعلًا واضح المعالم؛ فهي عملية الاستيلاء على جهد الآخرين، لفظًا أو معنى أو بنية، ونسبته إلى النفس دون إشارة أو إحالة، مع محاولة إخفاء المصدر أو تمييعه. والنتيجة نصٌّ مشوَّه، قد يُصفَّق له في أضواء الأمسية، ثم يُنسى حال انطفاء الميكروفون، لأنه يفتقر إلى جوهر الأصالة، ويقوم على فقر الخيال لا على غناه.
واللافت أن النقاد العرب القدماء كانوا أكثر صراحة وحسمًا في هذا الباب من كثير من النقاد المعاصرين؛ فقد صنّفوا السرقات الأدبية بدقة، وسمّوا الأشياء بأسمائها. فالنسخ – أو «النحل» – هو أقبحها، إذ يُنقل البيت كاملًا كما هو. والمسخ تغيير شكلي يحافظ على الوزن والقافية والمعنى. أما السلخ فهو أخذ المعنى كاملًا وصياغته بألفاظ أخرى، وهو عند بعضهم اقتباس إن أُضيف إليه جديد، وسرقة إن كان المعنى نادرًا مبتكرًا.ولم يسلم من هذه الاتهامات كبار الشعراء، كالمتنبي وجرير وأبي تمام، غير أن الفارق الجوهري أن هؤلاء الشعراء – حين أخذوا – طوّروا وعمّقوا وأضافوا، حتى غلب الجديدُ المأخوذَ عليه. أما اليوم، فكثير مما يُسمّى تناصًا لا يتجاوز إعادة تدوير المعنى نفسه بلا رؤية ولا إضافة، ثم الاحتماء بالمصطلح عند أول مساءلة.
وتكشف بعض القضايا المعاصرة، مثل اتهام الشاعر المصري هشام الجخ بالسطو على مربعات شعرية من ديوان «فن الواو» لعبد الستار سليم، عن عمق الأزمة لا عن حادثة فردية؛ إذ تُبرز كيف يمكن للشهرة أن تسبق النص، وكيف يُستباح التراث الشعبي حين يُظن أنه بلا حارس، ثم يُدافع عن ذلك باسم التناص أو المشاعية الثقافية.
إن صعوبة هذه القضية – كما يقول النقاد – تكمن في المنطقة الرمادية بين التناص والسرقة: بين التوارد المشروع على فكرة عامة، وبين الاستيلاء على تفصيلة مبتكرة، وبين الذاكرة الخفية التي قد تخدع الكاتب، والوعي الذي يتعمّد التغافل عن المصدر. غير أن هذه الصعوبة لا تبرر التسيّب، ولا تلغي معيارًا جوهريًا: هل غيّر النص الجديد دلالة الأصل أم كرّرها؟
في المحصّلة، ليست المشكلة في المصطلح، بل في من يستخدمه درعًا لا أداة قراءة. فالتناص لا يُقاس بحسن النيّة، ولا تُثبت شرعيته بكثرة التبريرات، بل بما يتركه النص الجديد من أثر مختلف في وعي القارئ. وحين لا يستطيع النص أن يقف وحده، ولا أن يدافع عن اختلافه، فغالبًا ما يكون الخلل فيه لا فيمن يشكّك به. عند هذه النقطة تحديدًا، لا يعود السؤال: «هل هذا تناص؟»، بل يصبح أكثر بساطة وصرامة: ماذا أضاف هذا النص إلى ما سبقه؟
إن كان الجواب: لا شيء، فكل المصطلحات اللامعة لن تغيّر الحقيقة!