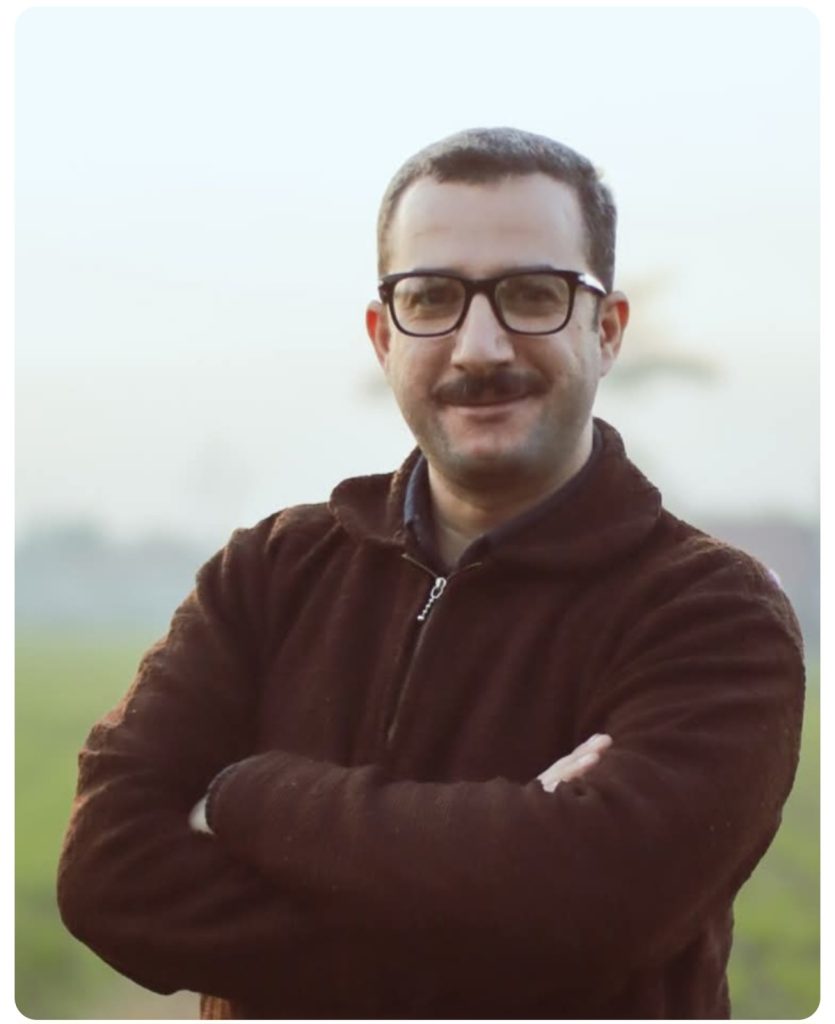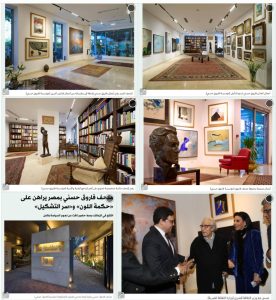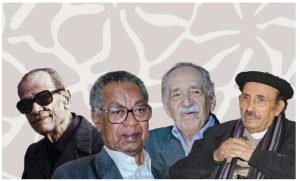أزمة الصورة الفوتوغرافية في عصر ما بعد الحداثة: هل يمكن للصورة أن تحمل الوعي أم أنها تُزيف التجربة؟
عزيزي المُتلقي، المهتم بفن الفوتوغرافيا، تخيل معي أنك تمشي في إحدى شوارع المدينة التي تختلط فيها الأنفاس بضجيج الخطى، تتدافع الوجوه من حولك كالأمواج المتلاطمة تحت وقاحة اللوحات الإعلانية التي تزهو بألوانها وكثافة حضورها الضوضائي. كل صورة تطل علينا منها ومن كل هاتف في كل يد تسعى إلى ابتلاع الواقع بطبقة سميكة من طوفان تبدلت معه الحدود. الحقيقة تذوب في التمثيل، والتجارب تتقلص بفعل الاستنساخ المتكرر، كأنه – أي الاستنساخ – صار كائنًا يتوالد بلا توقف، يشبه الجذر الذي يلتهم تربته، بينما الوعي – إن وجد – يذوب على السطح، والعمق تحول إلى رفاهية مهجورة، أو إن شئت قل: بلا قيمة في الحياة اليومية.
في هذا العالم يا عزيزي، والذي انخلعت فيه الأشياء من أصولها، باتت الصورة الفوتوغرافية أشبه بمرآة مكسورة، كل شظية منها تعكس وهجًا صغيرًا من حقيقة لا تكتمل إلا إذا دققت النظر من زاوية جريحة.
والحقيقة أن الضوء – من وجهة نظري الشخصية – في عصر ما بعد الحداثة الذي نحن فيه، أصبح مادة غير بريئة، صار موضع شك، بينما يطالب الظل ويلح من أجل حقه القديم في الظهور، إذ لم تعد الصورة مجرد أداة حفظ لما كان، بل تحولت إلى سلطة تحدد ما نراه وما لا ينبغي لنا رؤيته. ومع هذا التحول ولدت أزمتها: هل ما نراه هو ملامحنا الحقيقية، أم نسخة أُعيد تشكيلها تحت وطأة السوق، والذائقة العامة، وخوارزميات تستولدها رغبات لا تخصنا، وشهوة الظهور؟
في كتابه “الغرفة المضيئة” (Camera Lucida: Reflections on Photography, 1980)، قال رولان بارت: “الصورة جرحٌ، وأنا منفتح عليها كما ينفتح الجرح على السكين.”
في ظني أن بارت لم يكن يقصد الجرح بمعناه العنيف فحسب، بل تلك المنطقة الحساسة التي تتلامس فيها الذات مع العالم، الخيط الشفيف الذي يسمح للصورة بأن تلمس ما عجزت اللغة عن الإمساك به.
لكن السؤال اليوم: هل ما زال هذا الجرح ممكنًا في زمن صار فيه كل شيء مستنسخًا، متكررًا، ومُعدًا مسبقًا للاستهلاك؟ وهل ما زالت الصورة قادرة على إحداث تلك القشعريرة التي تحدث عنها بارت، أم أنها أصبحت مجرد صوت ضائع داخل ضجيج لا تنتهي؟
إن أزمة الصورة اليوم ليست في قدرتها على إغواء العين أو إبهارها، أي أن تكون جميلة، بل في قدرتها على امتلاكها شرعية الوجود نفسه. فالصورة لم تعد تعكس ما هو حاضر، بل ما يملى عليها أن تظهره، وما يراد لها أن تبرره. لقد صارت أشبه بكيان مُكلَف بأداء دور أعد مُسبقًا، بينما الحقيقة نفسها تقف خارج الإطار مقصية، يمارس عليها النبذ من أجل استمرار تلك اللعبة.
زمن ما بعد الحداثة هذا وعن حق اهتزازًا عميقًا في طبقات المعنى، كأن العالم فجأة كف عن الإيمان بالحقائق المؤكدة وبالسرديات التي كانت تُمسك بأطراف الوعي. ومع هذا الاضطراب المستفحل، لم تفلت الصورة من هذا التشظي، بل كانت إحدى ضحاياه.
فيليم فلوسر، أحد أبرز من اهتموا بتفكيك الصورة، يقول في كتابه المهم “نحو فلسفة جديدة للتصوير الفوتوغرافي” (Towards a Philosophy of Photography, 1984):
“الصورة ليست انعكاسًا للعالم، بل تقدم تصوراتنا وما نعتقده عنه.”
إنها شهادة كاشفة لوضع لم تعد الصورة فيه وسيطًا بريئًا، لقد أصبحت قوة يعاد عبرها تشكيل علاقتنا بالواقع، لا كما هو بل بقدر ما نقترب منه.
فلم تعد دليلًا يُطمأن إليه؛ صارت في كثير من الأحيان نفيًا له أو تنقيحًا مبالغًا فيه. ما نراه ليس ما وقع فعلًا، بل ما يُراد لنا أن نراه مما اختاره المُصوِر من زوايا، وما صاغته أدوات التحسين، وما أعادت الخوارزميات برمجته على المنصات لتبدو الحياة أكثر انتظامًا مما تحتمل.
إننا نعيش لحظة مُربكة، ففي الوقت الذي لا نستهلك الصور بقدر ما تستهلكنا، وتُشكل ذائقتنا، وتضعف حسنا بالواقع، تتسع الفجوة بين التجربة وبين تمثيلها.
ويا لتعس الإنسان، فبينما يحاول القبض على حضوره الحقيقي، يركع الواقع بل ويخضع لوطأة الصور التي تسبق خطاه وتعيد تعريفه.
هنا يظهر سؤال المركزي، الذي يقف في قلب هذا الجدل كله:
هل تستطيع الصورة أن تمثل الوعي؟ أم أنها تُزيف التجربة وتستعير مظهرها؟
ربما. فلا إجابة واحدة قد تغلق باب السؤال، ولكن حين تُلتقط الصورة بصدق يعي هشاشة الروح، وبعين ليست معجبة بالمشهد بقدر ما هي منشغلة بمعناه. تكون قادرة على حمل الوعي؛ علامة على وجود الإنسان وامتدادًا لوجدان صاحبها حين تولد من داخل التجربة، لا لاعتبارات السوق ولا لخطط الترويج. عندها فقط تصبح الصورة صدىً للإنسان، أثرًا من وجدانه، وامتدادًا لصوته الداخلي.
وعلى الرغم من أن الصورة بطبيعتها مجازًا بصريًا منذ البدء. تحاول الإمساك بما يفلت دائمًا، وترجمة ما لا يمكن أن يكتمل في إطار واحد مهما اتسع. تبقى في بعض الأحيان تلك التي لا يعرف المُصوِر نفسه كيف التقطها، ولا يعرف المُتلقي لماذا طعنته حين رآها تشبه الاعتراف، وتشبه الحنين، بل وتشبهنا نحن حين نكون أكثر صدقًا مما ينبغي، وأكثر هشاشة مما نريد، قادرة على النجاة من الزيف في هذا العالم المختنق بالضجيج.
.
وهكذا، يا عزيزي، حين نصل إلى آخر الممر الطويل الذي شيدته الصورة في عصرٍ التداعي هذا، يتضح أن السؤال لم يكن عن الصورة بقدر ما كان عن الإنسان وهو يحاول رؤية ذاته عبر ضوءٍ يلمع وظل يتخفى؛ فالصورة حين تُلتقط بروحٍ تصغي، حين تحمل ارتجافة التجربة لا زخرفها تكون تمثيلاً للوعي. لكنها، حين تُصنع لترضية رغبة عابرة أو لتجميل هشاشة تخشى التعري، تزور الواقع وتزيفه.
وبين هذين الحدين تظل بعض الصور – التي تولد بلا ادعاء – لأنها لا تجسد ما نراه، بل ما نشعر به، قادرة على أن تعيد إلينا بالتجربة وعينا الحائر كما يعود الضوء بعد انكساره: أكثر صدقًا، وأكثر شبهًا بنا مما نظن.