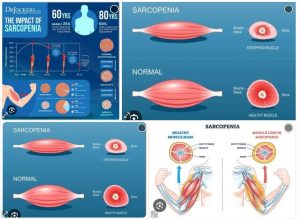قطار الأطفال”: السينما إذْ تناهض مظالم الحرب
جورج كعدي
سوف تروي السينما، بالتأكيد، مآسي أطفال غزة البلا شبيه في التاريخ، موتًا وبترًا وجوعًا ونزوحًا وأنهارًا من دم ودموع وألم. سوف تسجّل وقائع تفوق الخيال، وتجارب حقيقية تتجاوز المعقول، لطخةً سوداء في جبين الإنسانية. وردت في بالي هذه الخاطرة وأنا أشاهد عبر منصة “نيتفليكس” فيلم “قطار الأطفال/ Il treno Dei Bambini” للمخرجة الإيطالية كريستينا كومنشيني، ابنة الرائد والمعلّم الكبير لويدجي كومنشيني (1916 ــ 2007) أحد أسياد ما يدعى “الكوميديا على الطريقة الإيطالية/ Commedia all’italiano”، والذي ترك تحفًا من كل نوع، دراميّة وكوميديّة، وله ابنتان مخرجتان، فرنشيسكا، وكريستينا، مخرجة “قطار الأطفال”.لم أتوانَ عن رؤية وجوه أطفال غزة في وجوه أطفال إيطاليا البؤساء خلال الحرب العالمية الثانية. معاناة الطفل بما يمثّل من كينونة ضعيفة هشّة معرّضة قبل أوانها لعنف البالغين، وقسوة الحياة، نقع عليها هي نفسها في “برلين السنة صفر” لروبرتو روسليني، و”ماسحو الأحذية” لفيتوريو دي سيكا، و”طفولة إيفان” لأندريه تاركوفسكي. كلها لوجوه أطفال صافية نقية بريئة لا تفقه شيئًا من وحشية الحرب والعنف المحيط بها يحاصرها من كل جانب. هنا يسطع دور السينما الكبير في إيصال المعاناة، وتسجيل الزمن، وتوجيه الخطاب المناهض للحرب، أو يفقد هذا الفن الإبداعي النبيل وظيفة كبرى من وظائفه ومبرّرات وجوده كفنّ فاعل في المجتمع والتاريخ. أمست السينما المناهضة للحرب فئةً ونوعًا خاصّين في الفن السابع، وبات في مخزونها العالمي مئات الأفلام التي تعرّي وحشية الحروب والبشر القائمين بها، منذ العصور القديمة إلى الحربين العالميتين، فحروب فيتنام، والعراق، ولبنان، وفلسطين، مرورًا بكوسوفو، وبعض حروب أميركا اللاتينية.لست أرى فيلم “قطار الأطفال” إلّا ضمن فئة الأفلام المناهضة للحرب، وليس كما ينظر إليه بعضهم بكونه عن الأمومة والرابط العائلي والتربية، إلى ما هنالك من ثيمات أُسقطت عليه وليس منها في شيء. إنّه فيلم مناهض للحرب ونقطة على السطر. لولا الحرب ما كانت لتحصل عمليات نقل أطفال الجنوب الإيطالي (نابولي) البؤساء والجائعين والعراة والحفاة بسبب الحرب العالمية الثانية، إلى مناطق في الشمال الإيطالي كانت بعيدة عن تأثيرات الحرب المباشرة وتنعم بالاستقرار وبعض الرخاء. وما كان الأطفال اليافعون ليُسلخوا عن صدور ذويهم ويُنقلوا بالآلاف في ما سمّي آنذاك “قطارات السعادة” إلى كنف عائلات في الشمال الإيطالي، ويقيموا لديهم لفترة بعيدًا عن آبائهم وأمهاتهم، بمبادرة من الحزب الشيوعي الإيطالي والاتحاد النسائي الإيطالي، استمرّت بين عامي 1945 و1952، فكانت القطارات تنقل الأطفال من المناطق الفقيرة لتلقى الرعاية والغذاء والاستقرار الموقّت لدى أهل الوسط والشمال. وبرغم أن هذه المبادرة كانت عملًا تضامنيًا مفيدًا وضروريًا، انتقدها الديمقراطيون المسيحيون بشدة، ووصفوها بالدعاية الأيديولوجية للحزب الشيوعي، وشاعت في بعض الأوساط الشعبية أقاويل من نوع إنّ الشيوعيين يأخذون الأطفال إلى المنفى في سيبيريا، ويقطّعون أجسادهم ويأكلونهم، وتُسمع هذه الأقاويل والخرافات في الفيلم، وقبله في رواية الروائية الإيطالية فيولا أردوني التي تحمل العنوان نفسه قبل أن تتحوّل فيلمًا قويًا مؤثرًا.يعتمد الفيلم البنية الاسترجاعية (فلاش باك) التي تبدأ مع عازف الكمان الخمسينيّ المحترف أميريغو (ستيفانو أكورسي) يتهيّأ لدخول المسرح كعازف كمان أول مع الأوركسترا حين يرده نبأ وفاة أمه، فتتجمّد عواطفه، يحزن ويتردّد في الدخول إلى المسرح، ثم يستسلم لشريط ذكرياته مذ كان طفلًا يافعًا (كريستيان تشيرفوني، أميريغو في السابعة من عمره) يعيش في فقر مدقع وجوع مع والدته أنطونيتا (سيرينا روسّي) في نابولي التي دمّرتها الحرب، وتبدو علاقتهما في القسم الأول من الفيلم شديدة التوتر، بين حنان وقسوة، كره وحب، نفور واحتضان، بسبب الفقر والافتقار إلى أدنى مقوّمات الحياة. حتى أنّ أميريغو الذي تعدّه أمّه “عقابًا من الله” بسبب قوة شخصيته وعناده وثرثراته يظهر نحيلًا جدًا، جلدًا على عظم (يُطرح هنا سؤال حول كيفية إنزال وزن الصبي الممثل إلى هذا المستوى، وهل ينسجم ذلك مع أخلاقيات السينما وقوانين حماية الأطفال؟!) ويمضي وقته حافي القدمين، يحصي أزواج الأحذية لتعلّم الحساب، متسخًا بملابسه الممزقة، ومتشرّدًا مع صحب له في شوارع نابولي، حيث أعمال السرقة البسيطة لسدّ الجوع، وبيع الجرذان على أنها هامستر بعد طليها بالأبيض وقطع أذنابها، إلى ما هنالك من مظاهر بؤس تفوق بأشواط أحوال بؤساء هوغو وتشارلز ديكنز معًا.
لقطة من فيلم “قطار الأطفال”
“المأساة الإنسانية في فيلم “قطار الأطفال” ما كانت لتحصل لولا الحرب وظروفها شديدة القسوة. لذا، الموضوع الجوهريّ هو بلا أدنى شك الحرب وتبعاتها على البشر”
الفتى الجائع والمشاكس، الذي يشهد، فوق الجوع والبؤس، على غراميات أمه مع رجل متزوج، في غياب أبيه المسافر والمجهول المصير (كأن الرواية والفيلم يلمحان إلى هجره المتعمّد لزوجته وطفله) تضطرّ أمه، العاجزة عن القيام بأوده وإطعامه، إلى الانضمام إلى مبادرة مجموعة من النساء في الحزب الشيوعي ينظّمن بعد الحصول على موافقة الأهل نقل الأطفال الأشد فقرًا إلى شمال إيطاليا ليتلقوا الرعاية والطعام لدى عائلات ميسورة، أو شبه ميسورة، وبعد تردّد، تودّع أنطونيتا ابنها الذي ينتقل في “قطار الأطفال” إلى ريف مودينا، ليعيش بضعة أشهر لدى عائلة لطيفة، وليكتشف عالمًا جديدًا رغم معاناة الفراق. الشابة العزباء ديرنا (بربارة رونشي) تتلقّف الاهتمام بالفتى، من عائلة أخيها، بعد تردّد، لكنها سرعان ما تتعلّق به عاطفيًا، وتغدق عليه كل ما تملك من طاقة حنان وأمومة غريزية حُرمت منها، وأيضًا لكونها شيوعية ملتزمة ولديها ولاء لبرنامج المساعدة. هنا يدخلنا الفيلم، وقبله الرواية، في تناقض مشاعر أميريغو بين أمّه الجديدة وأمّه الحقيقية، إلّا أنه يلمس في النهاية صدق معاملة ديرنا له وحنانها، فضلًا عن اهتمام زوج ابنة عمها أستاذ الموسيقى (إيفان زربيتيني)، الذي يعلّمه العزف على الكمان بعد أن يكتشف لديه استعدادًا وموهبة، حتى أنّه يهديه كمانًا قيّمًا يأخذه أميريغو معه إلى نابولي إثر عودته، ليكتشف أنّ أمه لا تزال على حالها من التوتر والعصبية والقسوة والفقر، ولا تأنف من رهن كمان ابنها من أجل شراء الطعام، فيبدأ من هذه اللحظة افتراقه العاطفي عن أمّه، ويقفل عائدًا إلى مودينا، حيث أمه البديلة، ولكن الأحنّ والأكثر عطفًا، تاركًا أمّه الحقيقية في بؤسها حتى وفاتها…هذه المأساة الإنسانية ما كانت لتحصل لولا الحرب وظروفها شديدة القسوة. لذا، الموضوع الجوهريّ هو بلا أدنى شك الحرب وتبعاتها على البشر. ويعيد فيلم المخرجة كومنشيني إحياء الحقبة بدقة تفاصيل هائلة وإبداع مشهديّ تضافرت له جهود استثنائية، بدءًا بالإنتاج السخيّ (لـ”نيتفليكس” نفسها مع شركة بالومار)، الذي أتاح بناء ديكورات أمينة للأماكن التاريخية (ألبرتو دوياللي)، وقطار ومحطة في أربعينيات القرن الماضي، وملابس بديعة التصميم والتنفيذ (كيارا فيرانتيني) وموسيقى تصويرية غير ميلودرامية، بل تعبيرية (نيكولا بيوفاني)، وصورة وإضاءة مذهلتين لمدير التصوير إيتالو بتريتشوني الذي سبق أن تعاون مع المخرجة كومنشيني في “عند الليل” (2011)، و”العشيق اللاتيني” (2015)، وله عدد من الأعمال مع المخرج الإيطالي غبريالي سلفاتوريس. يهدينا في هذا الفيلم الحزين، البديع، صورة من أروع ما تحفظه ذاكرتنا السينمائية.لم أتعجّب كثيرًا كأحد عشاق سينما لويدجي كومنشيني لاكتشافي سينما ابنته كريستينا (لها تسعة وستون عامًا)، التي في رصيدها حتى اليوم ستة عشر فيلمًا في بلدها إيطاليا، مجهولة لدينا، وهي اكتشاف سعيد لي، وآمل أن يكون كذلك لكل من يشاهد فيلمها عبر نيتفليكس، المنصة الزاخرة بالغثّ والسمين، وممّا هبّ ودبّ، مع بعض الأعمال المضيئة، القليلة، التي نحظى بمشاهدتها بين الفينة والفينة. المخرجة كريستينا كومنشيني تبدو لي سرّ أبيها في هذا الفيلم البديع، المؤلم والمؤثر، المصنوع بحرفية عالية وإتقان يحاكيان حرفية الأب وإتقانه، ففي أحد الحوارات معها تقول: “إن جزءًا من صناعة الأفلام هو الجانب الحرفيّ، وهو ينتقل معظم الأحيان من الأب إلى الأبناء (…) لقد عشت تجربة السينما منذ الصغر، الكتابة بالنسبة إليّ أمر طبيعيّ، لكن إخراج الأفلام صعب. إنه يرهقني ويقلقني، بدأت في سنّ متأخرة”.في العصر الذهبيّ للنقد السينمائيّ، كانت عبارة “على مسؤوليتي” شائعة، وأستعيدها لأقول شاهدوا “قطار الأطفال” على مسؤوليتي.*
ضفة ثالثة
مجلة ايليت فوتو ارت