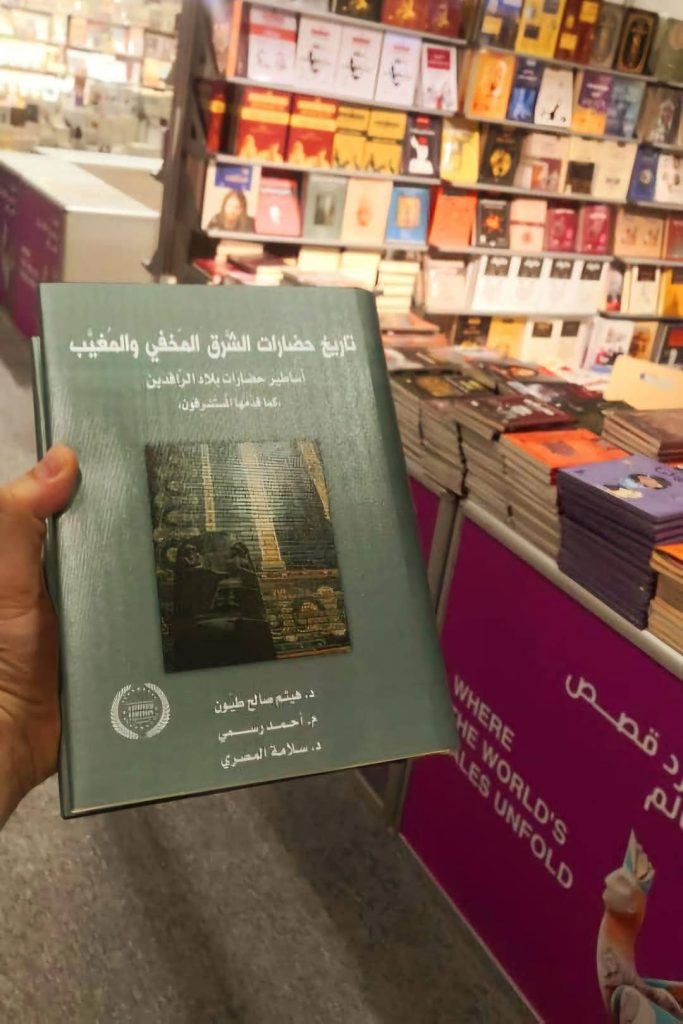🖋 إدوارد سميث Edward Smith
في السّرديات التاريخية لا ينتَصِر الحدث بذاته، بل تنتصر الرواية التي تمتلك سلطة التدوين. فالتاريخ، كما أثبتت دراسات نقد الخطاب التاريخي الحديثة، لا يُنقَل بريئًا عبر القرون، بل يُعاد تركيبه وفق ميزان القوة، وحاجات الدولة، وأيديولوجيا المُنتَصِر. من هذا المنطلق لا يمكن التعامل مع ما يُعرف اليوم بـالتراث الإسلامي بوصفه سجلًا تاريخيًا، بل بوصفه منتجًا سياسياً – أيديولوجياً مُتأخرًا تشكّل في ظل سلطة مركزية امتلكت القرار والمال وأدوات الصّياغة. ما توصّلنا إليه في هذا الكتاب لا يطرح مجرد تشكيك جزئي، بل يقدّم اتهامًا بنيويًا مُتماسكًا: أنّ الدولة العُثمانية، في لحظة توسُّعها الإمبراطوري، دخلت في توافُقات استراتيجية مع ممالك غرب أوروبا لإعادة هندسة تاريخ الشرق الإسلامي برمّته، عبر نقل مسرح الأحداث من شبه الجزيرة الإيبيرية، حيث نشأت الجذور الحقيقية للحركات المَسيحانية التوحيدية، إلى جغرافيا مُصطَنَعة في الحِجاز وبلاد الشام. لم يكن ذلك عملًا عشوائيًا ولا جهد أفراد مُتَفرِّقين، بل مشروعًا مؤسسيًا واسع النِّطاق، أُنجِزَ عِبرَ ما يُمكِن تسميته اليوم ورش كتابة تاريخ، جرى فيها إنتاج السّيرة النّبوية والأحاديث، وكتب التفاسير، والأنساب، وفق نموذجٍ واحد يخدم شرعنة السُّلطة الجديدة. في هذا السِّياق يصبح النظر إلى أسماء مثل إبن تيمية والبُخاري ومُسلم والطّبري وإبن كثير والذّهبي وإبن حجر العسقلاني وأبو داود وإبن ماجه والنِّسائي وياقوت الحموي وكثيرين غيرهم خارج إطار التّقديس ضرورةً منهجية، لا موقفًا انفعاليًا، فهذه الأسماء لا تُمَثِّل شهود عيان على القرون الأولى، بل تُمَثِّل مرحلة تدوين متأخرة، كُتِبَت بعد زمن وقوع الأحداث المفترضة بمئات السنين، في زمن كانت فيه الخِلافة قد استقرّت، والمَذهب قد تبلوَر، وكانت السُّلطة بحاجة إلى ماضٍ مُتماسِك يُضفي الشّرعية على الحاضِر. الشق الأخطر في هذه العملية هو التّداخُل العضوي بين البلاط العُثماني وشبكات المال اليهودي السّفاردي في القرن السادس عشر الميلادي، حيث برز إسم يوسف ناسي بوصفه ليس مجرد مُمَوُّل، بل مديرًا فعليًا للشؤون المالية والسياسية للبِلاط السُّلطاني العُثماني، وصلة الوصل ما بين اسطنبول وعواصم أوروبا الغربية. في هذا الإطار لم تعُد كتابة التاريخ فعلًا ثقافيًا، بل عملية استخباراتية اقتصادية، شارك فيها لاحقًا مُستَشرِقُون يهود نمساويون، وضباط استخبارات بريطانيون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، الذين أعادوا تدوير هذه المادة وصقلوها أكاديميًا، ثم قدّموها للعالم بوصفها التاريخ الإسلامي الموثوق. عند هذه النقطة يفقد التراث قيمته المعرفية، لأنه لا يعود مصدرًا، بل يصبح موضوعًا للدراسة النّقدية. فالنّصوص التي قامت على التزوير، ونقل الجغرافيا، واختلاق الشخصيات، لا تُناقَش بوصفها شواهِد، بل تُفكَّك بوصفها أعراضًا لسُلطة كتَبَت ماضيًا يخدمها. ومن هنا فإن الدعوة إلى التّعامُل مع هذه الكتب بابتسامة ساخِرَة ليست دعوة إلى العدمية، بل إلى تحرير العقل من وَهم المصدر المُقَدَّس، وإعادتها إلى مكانها الطبيعي: مادة أيديولوجية صُنِعَت لتضليل الوعي، لا لتنويره. بهذا المعنى، لا يكون إسقاط القيمة التاريخية عن كتب الأحاديث والتفاسير والأنساب موقفًا متطرفًا، بل نتيجة منطقية لتحليل بُنيتها، وزمن كتابتها، ووظيفتها السياسية. وما لم يُعثر على أثر مُعاصِر مُستَقل سبق تلك الورش العُثمانية – الاستشراقية، فإنّ هذه المدونات لا تستحق أن تُعامَل بوصفها تاريخًا، بل بوصفها نفايات سردية تراكمت عبر القرون، آن أوان فرزها، لا ترديدها!!
ما كشفته صفحات هذا الكتاب، حين تُقرأ قراءة تاريخية نقدية مُتماسِكة، ليس غزوًا عربيًا بالمعنى العسكري التقليدي، بل انتقالًا داخليًا معقّدًا داخل شبه الجزيرة الإيبيرية، سبقته تحولات دينية واجتماعية عميقة. فالسّردية المدرسية التي تتحدث عن جيوش جاءت من الحِجاز بكتابٍ مُكتَمِل إسمه “القرآن” لتفتح الأندلُس، تصطدم بغياب الأدلّة المُعاصِرَة لهذا السيناريو، وبحضور قرائن أقوى تشير إلى ثورة داخلية ضد السُّلطة التثليثية (روميّة بيزنطية أرثوذوكسية ورومانية كاثوليكية)، قادتها نُخَبٌ دينية محلّية ذات خلفية مورية إبيونية قرّائية – قوطية غربية وفاندالية أريوسية، كانت تمتلك نصوصًا وعقائد توحيدية سابقة على الإسلام بصيغته المتأخرة. السؤال الذي طرحته صفحات الكتاب حول “أيّ كتابٍ كان مع الدّاخلين؟” سؤال كاشِف بحد ذاته، لأنّ افتراض وجود قرآن مدوَّن كاملًا ومُتداولًا في مطلع القرن الثامن الميلادي لا يسنده دليل مخطوطي ولا إشاري، فأقدم الشواهد القرآنية المادية المعروفة ظهرت لاحقًا، وفي سياقات لاهوتية جدلية، لا في سياق فتوحات عسكرية. ما كان حاضرًا في أيبيريا آنذاك هو جسد Corpus نصّي مسيحاني توحيدي، تشكّل من أناجيل غير قانونية، ونصوص إبيونية، وتعاليم قرّائية يهودية وإنجيل فضّي قوطي، دخلت جميعها في صِراع مُباشِر مع عقيدة التثليث ومع قسوة الإكليروس في شبه الجزيرة الأيبيرية؛ ما يُفسِّر لماذا تدعو بعض السُّوَر والآيات المكيّة المبكرة إلى قِيَم العدالة الإجتماعية كإغاثة الفقراء، وإطعام المساكين، وحسن الجوار والبِرّ بالوالدين وغيرها بوصفها جوهر الدّين الجديد (ومنه لقب القِس وَرَقَة بن نوفل Nuevo أي “جديد” بالإسبانية)، في مقابل سور وآيات لاحقة كُتِبَت بعد مقتله حمَلَت نبرة عدائية صِدامية، عكست مراحِل صِراع داخلي وتحوّل سياسي وعسكري انتحاه أتباع ذلك الدّين الجديد. من هنا يغدو توصيف ما جرى بوصفه ثورة شعبية داخلية أكثر اتساقًا مع المُعطيات من سردية “الغزو العربي لإسبانيا”. فالقوط أنفسهم كانوا مُنقسمين لاهوتيًا، والأريوسية كانت مُتَجذِّرَة في المُجتَمع، ما أتاح انتقال السُّلطة بأقل قدر من الدّمار، وبمُشاركة فاعِلين محلّيين. أمّا إقحام أسماء قادة ووقائع ومعارك من نمط بدر وإسقاطها جغرافيًا على إسبانيا، فيبدو جزءًا من إعادة كتابة لاحِقة هدفت إلى توحيد السّردية، ونقل المسرح إلى الشرق، ومنح التاريخ الجديد أبطالًا وفتوحات وخرائط تخدُم دولة مركزية نشأت بعد ذلك بقرون. بهذا المعنى، فإنّ النُّصوص التُّراثية التي تُستَحضَر لتأكيد الغزو لا تعمل بوصفها مصادر أولية، بل بوصفها مُنتجات أيديولوجية متأخرة. قيمتها البحثية لا تُستَمَد من قُدسيتها، بل من تحليل بُنيتها وزمن تدوينها ووظيفتها السياسية. عندما نضعها في هذا الإطار، تتبدّى الأندلُس لا كأرض فُتحت بجيش خارجي، بل كمختبر أوروبي متوسطي تشكّل فيه الإسلام المبكر بوصفه تعبيرًا مسيحانيًا توحيديًا محليًا، قبل أن يُعاد تعريفه، ونقل جغرافيته، وصياغة تاريخه النِّهائي لاحِقًا. الخلاصة أن هذه الشواهد، مُجتمعة، لا تهدُم التاريخ بدافع الإنكار، بل تُعيد ترتيب الأسئلة على أساس الدليل: من كتب؟ متى؟ ولماذا؟ عندها فقط يتّضح أنّ الغزو كان سردًا، وأنّ التّحوُّل الحقيقي كان داخليًا، وأنّ الكتاب والدّين الذي تشكّل وتبلوَر لاحِقًا حَمَلَ آثار هذا المَسار، لا خارِطة جيش عربي مُسلِم آتٍ من صحاري شبه الجزيرة العربية كان عابِراً للبِحار!!!
#مجلة إيليت فوتو آرت