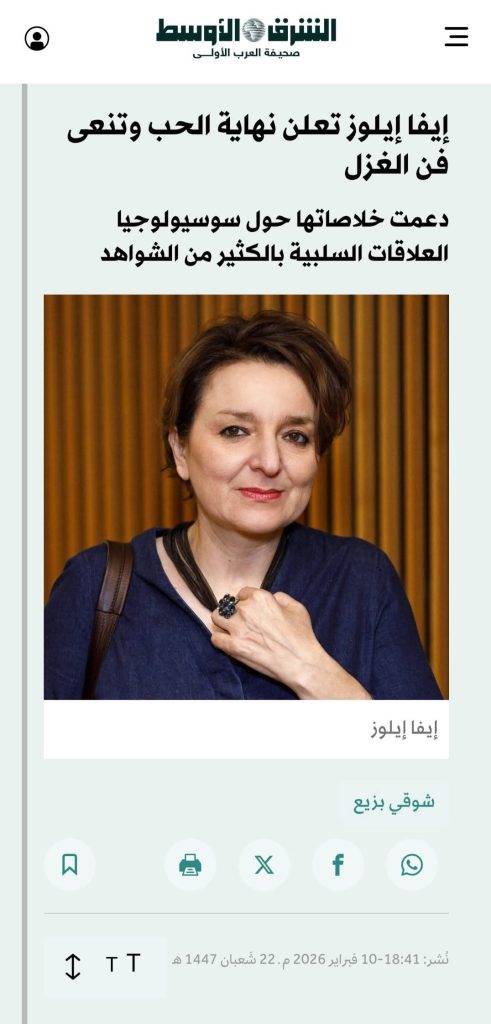دعمت خلاصاتها حول سوسيولوجيا العلاقات السلبية بالكثير من الشواهد ايفا إيلوز تعلن عن نهاية الحب وتنعى فن الغزال لم يكف المفكرون وعلماء النفس والاجتماع الغربيون منذ بدايات القرن الفائت, عن تناول الأسباب العميقة التي أدت الى تدهور العلاقات العاطفية بين البشر, في ظل الاستشراء المتعاظم لنظام القيم الرأسمالي , الذي يقع الجشع والمنفعة وجباية الملذات في رأس أولوياته. وإذا كان الباحث البولندي زيغمونت باومان قد تحدث في كتابه ” الحب السائل “, الذي تم تناوله في مقالة سابقة , عن لزوجة الروابط الانسانية الحديثة , فإن الباحثة الفرنسية إيفا إيلوز قد ذهبت في كتابها ” نهاية الحب ” الى أبعد من ذلك, فتحدثت عن ضمور الحب وسقوطه المريع تحت الضربات الهائلة والمتصاعدة للمطرقة الرأسمالية . ولعل أكثر ما تؤكد عليه إيلوز في كتابها القيّم والمستفيض, هو أن التحول الذي حدث في العلاقات الانسانية , هو أخطر من أن يترك في عهدة علماء النفس بمفردهم, لأن لدى علم الاجتماع الكثير مما يقوله في هذا الشأن , حيث أن ” اللايقين العاطفي الذي يسود في مجالات الحب والرومنسية والجنس, هو النتيجة السوسيولوجية المباشرة للطرق التي أدمج بها سوق الاستهلاك والصناعة العلاجية وشبكة الإنترنت , من خلال الاختيار الفردي الذي بات الإطار الرئيسي للحرية الشخصية “. وترى إيلوز في كتابها أن الحب الذي كان موجهاً للآلهة ومسنوداً بقيم دينية وسماوية, قد انتقل في العقود الأخيرة الى نوع من الفردانية التملكية والجنسية, التي تسوغ للمرء اتصالاً جسدياً مع من يختاره بنفسه . وقد بدأت لبنات هذه ” الحداثة العاطفية ” بالظهور في القرن الثامن عشر. على أنها لم تتحقق بشكل كامل إلا بعد ستينيات القرن العشرين, سواء تجلى ذلك عبر الاقرار الثقافي بحرية الاختيار العاطفي, أو عبر إعلاء مبدأ اللذة والمتع الافتراضية التي وفرتها الشبكة العنكبوتية . وقد كان عالم الاجتماع المعروف إميل دوركهايم من أوائل الذين أدركوا مغزى انهيار النظام العاطفي والمعياري والمؤسساتي للعلاقات الانسانية . فهو قد ركز في بحوثه على البشر المصابين بالأنوميا, أو الشراهة المفرطة, الذين يجدون متعتهم في العلاقات الحرة وغير المقيدة بأي شيء سوى المتعة نفسها . وبما أن الانسان الشره يتعلق بكل من ينال إعجابه, ولا شيء يرضيه على الاطلاق, فسوف تدركه لعنة اللانهائي, التي لا ينتج عنها سوى البلبلة والاضطراب النفسي, وصولاً الى الانتحار . وفي سياق الضمور التدريجي للحب الرومنسي وسيادة اللاحب, تتيح الحياة المعاصرة للبشر الباحثين عن كسر العزلة, الفرصة الملائمة لنسج علاقات عاطفية أكثر يسراً من السابق, إلا أنها تقدم الشيء ونقيضه في آن . فهي إذ تساعدهم من ناحية على تعريف أنفسهم عن طريق الاختيار الحر وتحقيق الرغبات, يتخذ تعريف الذات أشكالاً سلبية تتمثل بالإعراض والتردد والحيرة والصد المتكرر ونبذ العلاقات , بما أكسب الاختيار طابع اللاإختيار, وحوّل فائض الحرية الى نعمة ونقمة في آن .والواضح أن الحداثة , التي عملت في البداية على تحرير الحب والصداقة والعلاقات الانسانية من الأغلال, ما لبثت بتأثير واضح من نمط العلاقات الرأسمالية, التي يشكل نظام العقود بين الشركات عنوانها الأبرز,أن حولت الحب الى علاقة استثمارية تعاقدية بين طرفين, يحرص كل منهما على تحصيل أقصى ما يستطيعه من الأرباح . لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد, بل إن القدرات التواصلية الفائقة للحداثة, قد أفضت في وقت لاحق الى خلخلة العلاقات الاجتماعية التقليدية, أو نقلها الى خانة سلبية بحتة . والبراهين على ذلك كثيرة ومتنوعة, من بينها المواعدات العرضية,والاكتفاء بالعشيق المؤقت أو رفيق المتعة, والنأي عن أي وعد ملزم, وإخلاء العلاقات من أي شبهة شاعرية . وتستعيد المؤلفة في هذا السياق, وبالكثير من النوستالجيا, الوجوه والمفاهيم السابقة للحب, سواء تعلق الأمر باليوتوبيا الصوفية, أو بالتقشف المسيحي, ممثلاً بأوغسطين وتوما الأكويني ,والذي يكاد يحص العلاقة الجسدية في نطاق الانجاب والتكاثر, أو بالحب الفروسي الذي ساد في العصور الوسطى, وأنتج قصائد رائعة في التوله العشقي . وهي تضع في السياق نفسه, رؤية إيمانويل كانط الأخلاقية الى العلاقات العاطفية, التي لا ينبغي حسب قوله ” أن تجعل من الشخص الآخر موضوعاً للشهوة, ثم تطرحه بعد إطفائها كما يُطرح الليمون بعد عصره “.وهي إذ تفعل ذلك فلتبين بوضوح كيف أن النظام الرأسمالي, وبخاصة في ظل التطورات المتسارعة لوسائل الاتصال, لا يقرأ إلا في كتاب الاستثمار وتحصيل المكاسب, بدليل أنه فصل الجسد الانساني عن أي مرجعية أخلاقية واجتماعية, وحوّله الى مرجع قائم بنفسه وذاتي الإحالة, ومفصول عن الأجساد الأخرى وباقي الأشخاص . وإذا كانت الجنسانية غريزة طبيعية, فيمكن للجسد الجنسي أن يصير فيزيولوجيا خالصة محكومة بالهرمونات والنهايات العصبية .وإذا كانت التحولات الدراماتيكية التي أدخلها نظام المنفعة الرأسمالي على سلم القيم المألوف, قد أصابت الحب في صميمه, فهي قد أصابت بالطريقة ذاتها فن الغزل, سواء ما تعلق منه بالشعر, أو بقواعد المغازلة القديمة على اختلاف مستوياتها وأغراضها . صحيح أن المغازلة لم تكن تتم على الدوام في سياق التمهيد الصادق للارتباط النهائي بالآخر, بل كان بعضها يقع في خانة الإغواء الشهواني للطرف المعشوق واستدراجه الى علاقة جسدية عابرة, ولكنها ترتكز في جميع الحالات على مجموعة واضحة من القواعد الاجتماعية التي تنظم المشاعر والعواطف والتفاعلات في مسارات ثقافية محددة المعالم والغايات.ولعل أهم ما تمنحه أشكال المغازلة التقليدية للمتغزلين, هي أنها تخرجهم من حالة التذرر واللايقين التي تحكم في العادة شخصية البشر المتوحدين, أو المهووسين بإرضاء نزواتهم, وتدرجهم في سياق بنية سردية وسوسيولوجية, محددة المقدمات والنتائج . فالمغازلات الغرامية ما قبل الحديثة كانت, وفق دوركهايم, مرتبطة بمجالات للطاقة شديدة التكثيف, وقادرة عبر ديناميتها الفاعلة وظهيرها العاطفي, على إكساب العلاقة بين الطرفين ما يلزمها من الفاعلية والجدوى, وما يخفف بالتالي من وطأة الغموض واللايقين. لم يكن اختفاء المغازلة الغرامية بهذا المعنى, سوى المحصلة الطبيعية للحرية الجنسية, التي لم يلبث أن أمسك بزمامها جهاز مؤسَّسي لا يقيم للمشاعر الانسانية القلبية أي وزن يذكر. فإذا كانت الحرية قد شكلت الشعار الايديولوجي للحركات الاجتماعية والسياسية, فإنها باتت بالمقابل الذريعة التي يتوسلها طالبو المتع الحسية المجردة لتحقيق غاياتهم, وإخلاء حياتهم من أي معنى يتجاوز هذه المتع . وقد عززت الرأسمالية “المرئية” هذا الشكل من الاستغلال المكثف والواسع للجسد الجنسي, من خلال صناعة الصور والسرديات التي لم تكف التكنولوجيا المتطورة عن توفيرها لهواة النوع . وهو ما جعل العلاقات القائمة بين البشر, تأخذ شكل المقايضات المتبادلة التي تتم بين غرباء, يقوم كل منهما بإسداء خدمة مُرْضية للآخر .لكن المفارقة اللافتة في هذا النوع من العلاقات التي تعززها الرأسمالية النيوليبرالية, هي أن التمحور الغرائزي حول الذات الظامئة أبداً الى التحقق, يقابله تهديد عميق للهوية الفردية والاجتماعية على حد سواء, بحيث أنني “لا أستطيع أن أقول من أنا وماذا أريد “. وفي ظل هذا النوع من العلاقات المعولمة، تسود بنية جديدة للشعور تتأرجح بين المجالين الاقتصادي والجنسي, وتجد تعبيراتها في المرونة الزائدة ، والانتقال من شريك الى آخر، وعدم الولاء . وهو ما جعل انعدام الاحساس بالأمان ،يسير جنباً الى جنب مع التنافسية المطلقة وغياب الثقة .ولعل أخطر ما تسبب به الانهيار التراجيدي لعلاقات الحب الوثيقة ، هو أن اختفاء الروح من المشهد الغرامي، قد ترك الجسد يخوض وحيداً وبلا ظهير, معركة إثبات الفحولة والتنافس القاسي على الخواء. وهو ما جعل أضراره تتعدى الاحساس بالفراغ الروحي والميتافيزيقي ، لتصل ببعض الخاسرين في َسباق الفحولة الى الانتحار ، كما حدث لبطل ميشيل ويلبيك في روايته ” توسيع دائرة الصراع ” .وإذ تلح إيفا إيلوز في خاتمة كتابها, على أنها ليست معنية بتقديم المواعظ الأخلاقية, ولا الدعوة الى تضييق هامش الحرية, أو الحث على العودة الى بيت الطاعة الأسري , تؤكد بالمقابل على كونها معنية بأن يجد سعار الشهوات المحمومة , وفوضى الغرائز المنفلتة من أي وازع, طريقهما الى التراجع . وإذا كانت الحرية الفردية هي المبدأ الحقوقي الذي يتذرع به الكثيرون لتبرير انفلاتهم الغرائزي, وتهالكهم على الملذات , فلماذا لا تكون الحرية بالمقابل بمثابة الذريعة الملائمة لرفع الستار عن كنوز الروح وجمال الحب وفتنة اللامرئي . # العالم الرقمي يسخر من الواقعي# مجلة ايليت فوتو ارت.