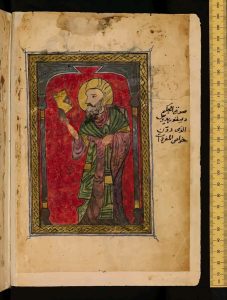حبيبي حسين”: عن ترميم السينما ومحو الذاكرة في فيلم “حبيبي حسين”
يوسف الشايب
فيلم “حبيبي حسين” للمخرج الفلسطيني المقيم في برلين، أليكس بكري، ليس مجرد توثيق لعملية ترميم “سينما جنين” الشهيرة في الضفة الغربية، بل مرثية بصرية وصوتية لرجل ذاب في المكان حتى صار هو المكان ذاته، ووثيقة إنسانية صادمة حول صراع الروايات وفوقية المانح في مقابل أصالة ابن المكان، فالفيلم، الذي هو من إنتاج الفلسطينية مي عودة، يطرح سؤالًا جوهريًا: هل يمكن ترميم الحجارة عبر سحق الذاكرة الحية التي كانت تحرسها؟!
وينتمي الفيلم إلى سلالة من الأفلام الفلسطينية التي تتخذ من الواقع نقطة انطلاق، ومن التجربة الفردية نافذة إلى معنى جماعي، إلا أنّ “حبيبي حسين” يمارس خطوة إضافية، بحيث يفكّك البنية التي تحيط بالمشروع الثقافي نفسه، ويعرّي الطبقات الاستعمارية الجديدة المفروضة على الوعي الفلسطيني.
تقوم رمزية الفيلم على ثلاث ثنائيات مركزية: الفرد في مقابل المؤسسة، والمحلي في مقابل الأجنبي، والرواية الفلسطينية في مقابل الرواية المموّلة، وهذه الثنائيات ليست سردية فقط، بل بصرية فكرية تؤسس لبنية رمزية متماسكة.
على السطح، تدور الحكاية حول مشروع طموح لإعادة إحياء “سينما جنين” التي أغلقت أبوابها لسنوات طويلة (منذ انتفاضة الحجارة في عام 1987 تقريبًا)، وذلك بتمويل وإدارة ألمانية بقيادة المخرج ماركوس فيتر، لكن الحكاية الحقيقية تتمحور حول مأساة “حسين”، الرجل الستيني الذي قضى عمره مُشغّلًا لهذه السينما، والذي حلم لعقود بعودتها، ليجد نفسه عند تحقيق الحلم غريبًا في بيته، ومهمشًا لصالح الكفاءة الغربية والبهرجة الرسمية.
يسير الفيلم في خط زمني يواكبه تدهور نفسي للبطل، ففي البداية نرى حسين سيّدًا للمكان المهجور، يُصلّح الكراسي بيده، يتحدث عن الماكينات القديمة بحب (“حبيبي” و/أو “حياتي”)، يملك السلطة المعنوية على الخراب، وفي الوسط، حيث الصراع، نشهد دخول العنصر الأجنبي (ماركوس والفريق الألماني)، بحيث يبدأ التصادم بين الخبرة العتيقة لحسين والتكنولوجيا الحديثة للألمان، فحسين يريد عرض أفلام “كاراتيه” وهندية تجذب البسطاء، بينما يريد ماركوس تحويلها إلى “مركز ثقافي”، وعرض أفلام وثائقية للنخبة.
وتبلغ الذروة في حفل الافتتاح الضخم، حيث يحضر المسؤولون والوزراء الفلسطينيّون، بينما يقف حسين تائهًا، لا أحد يذكره، ولا أحد يشكره، بل ويتم التشكيك في دوره الوظيفي وراتبه، فيظهر حسين وحيدًا، مطرودًا فعليًا أو معنويًا، بينما المكان يضج بحياة لا تشبهه.
الشخصية المحورية (حسين)، ليس مجرد مُشغّل سينما، هو رمز للفلسطيني الأصيل، بل إن رمزيته هنا تعادل رمزية الشعب الفلسطيني نفسه: يعمل في الخلفية، ويصنع الحياة اليومية، لكنه يُقصى حين يحضر أصحاب النفوذ.
إنّه العفوي، الذي يرتبط بالأشياء عاطفيًا لا وظيفيًا، لذا فإنه يمثل، أيضًا، الذاكرة الشعبية، والبساطة، والزمن الجميل الذي ولى… هو “دون كيشوت” الفلسطيني الذي يحارب طواحين الهواء (التكنولوجيا الحديثة والإدارة الغربية) بسلاح صدئ (ماكيناته القديمة التي تعمل بالفحم)، فيما تكمن مأساته في اعتقاده أن المانحين جاءوا لأجله، ليكتشف أنهم جاءوا لأجل “المشروع”… جملته المتكررة “أنا 45 سنة هون” هي صرخة لإثبات الوجود أمام محاولات المحو.
لا يظهر حسين كبطل خارق، ولا كمثقف، ولا كقائد مشروع، بل كعامل بسيط يشغّل “البروجيكتور”، وهذا يضعه في خانة الفاعل الخفي الذي يصنع الصورة من دون أن يكون جزءًا منها. هو صوت غير مصقول، مباشر، غير مصنوع، ووجوده في السينما يعني أن الثقافة الفلسطينية، إن تُركت لنفسها، ستنشأ من الفطرة، والذاكرة، والصدق، أمّا استبعاده لاحقًا فيكشف البعد الرمزي لقمع الصوت الأصلي.
أمّا حركته، وصوته، وكلماته العامية، وطريقته في الشغل، وعلاقته بالسينما، كلها تكوّن لغة جسد فلسطينية لا يمكن تحويلها إلى لغة أو لغات أوروبية أو إزالة سُمرتِها بتبييض ثقافي.
لم يكتفِ أليكس بكري بتوثيق الحجر، بل وثق انكسار الروح
الشخصية المُقابِلة (ماركوس فيتر)، يمثل الرجل الأبيض (المُخلّص) الذي يأتي بنوايا حسنة ظاهريًا (ترميم السينما، والسلام، وتعزيز الثقافة)، لكنه يمارس، بوعي أو بدونه، استعمارًا ثقافيًا وفوقية إدارية، عاكسًا العقلية الغربية البراغماتية التي ترى في “حسين” عائقًا تقليديًا يجب تحييده لنجاح المشروع “الحديث”، فهو يهتم بالصورة النهائية للمشروع أمام العالم، بينما يهتم حسين بروح المكان.
الشخصيات الثانوية تتمثل في المسؤولين ممّن كانوا في حفل الافتتاح، ويعكسون حالة من الانفصال عن الواقع، بحيث يحتفلون بالإنجاز الإسمنتي ويتجاهلون الإنسان، كما تتمثل في أصدقاء حسين، الذين يُكوّنون الحاضنة الشعبية التي تفهم لغته وتشاركه اغترابه.
في أحد المشاهد المفصلية، يحاول حسين إقناعهم بتشغيل الماكينة القديمة التي تعمل بالفحم (القوس الكهربائي)، بينما يصر الألمان على العدسات الرقمية الحديثة، وهذا ليس خلافًا تقنيًا، إنّما صراع بين أصالة غير فعّالة وحداثة مغتربة، حيث يريد حسين أن يشم رائحة السينما القديمة، بينما يريدون هم صورة نقية بلا روح.
أمّا اللحظة التي يُطلب فيها من حسين تسليم المفاتيح أو عدم امتلاكه لقرار فتح الباب، فترمز إلى سلب الولاية الفلسطينية على المكان، حيث إن المانح هو من يملك المفتاح، وصاحب البيت بات ضيفًا ثقيلًا.
وعندما يُطالَب حسين بحقه المالي ويُقال له “أنت متطوع” أو يُعطى مبلغًا زهيدًا، يتجلى مفهوم الاستغلال العاطفي، حيث تم استهلاك صورة حسين للترويج للفيلم وللمشروع (الرجل العجوز الذي يحب السينما)، وبمجرد انتهاء الحاجة التسويقية له، تم التخلي عنه.
وتبرز سينما جنين في الفيلم كمعادل للذاكرة، فهي ليست مكانًا للعرض، إنّما مستودع للذاكرة المجتمعية، والمكان الذي يُرى فيه الفلسطينيون ويُعيدون رؤية أنفسهم، لذا فإن بيع السينما في الفيلم ليس صفقة، بل محو وإعادة كتابة لذاكرة المكان.
“الفيلم يشتبك بجرأة مع رمزية التمويل، مقدّمًا إياه كأشكال جديدة من الاستعمار، فليست المساعدات مجرد دعم، بل نظام ضبط”
أما “البروجيكتور” فهو رمز للسلطة على السرد، وليس مجرد آلة، إنه جهاز إنتاج الصورة، ومن يملك تشغيله يملك حق إطلاق الرواية، وحين يُقصى حسين عن جهاز التشغيل، تتحوّل الآلة إلى رمز انتزاع الحق في السرد.
بدخول التمويل الأجنبي، تتحول السينما من مكان شعبي إلى مساحة مؤطّرة يجب أن تلتزم بالقواعد نفسها التي تفرضها أوروبا على مشاريعها الثقافية في العالم، وهكذا تصبح السينما نموذجًا مصغرًا لفلسطين نفسها: مكان له أصحابه الأصليون، لكنه يُدار من آخرين.
ولم يكن اختيار جنين كحاضنة مقاومة، مُحايدًا، فهي المدينة التي تحمل ومخيّمها تاريخًا طويلًا في المقاومة، لذا فإن وجود مشروع ثقافي غربي فيها يجعل رمزية الصراع أوضح.
الفيلم يشتبك بجرأة مع رمزية التمويل، مقدّمًا إياه كأشكال جديدة من الاستعمار، فليست المساعدات مجرد دعم، بل نظام ضبط: ما يُسمح بعرضه، وكيفية إدارة السينما، ومن يشغلها، وهذه الشروط هي جوهر “الاحتلال الثالث”: لا يفرض السيطرة بالقوة، بل بالإعالة، وبالإدارة، وبإعادة تعريف المسموح ثقافيًا، بحيث ترصد الكاميرا لحظات يفرض فيها طرف خارجي تعليماته، وهي مشاهد تحمل قيمة رمزية كونها تكشف كيف يتحول الدعم الثقافي إلى آلية لتنظيم المجتمع والتحكم فيه.
واعتمد الفيلم أسلوب ما يسمى بـ”الذبابة على الحائط”، حيث تتابع الكاميرا الأحداث بدون تدخل، وتترك التناقضات تظهر وحدها، وهذا الأسلوب فضح النوايا من دون حاجة إلى تعليق صوتي، فالكاميرا كانت منحازة عاطفيًا لحسين، تلاحقه في زوايا العزلة بينما تسلط الضوء على “برود” الطرف الآخر.
الإيقاع البطيء نسبيًا في الفيلم ليس عيبًا جماليًا، بل خيار رمزي، فهو انعكاس لفرضية بطء الفلسطيني في مقابل استعجال الممول من جهة، علاوة على كونه يخلق مساحة للتفكير التأملي، كما يمنع الصورة من التحول إلى منتج استهلاكي سريع… وحين يتابع الفيلم تفاصيل بسيطة في حياة حسين، فهو يقول إن اليوميّ مقاومة، بل ويعيد مركزية الإنسان، لا الوثيقة.
وكان استخدام أغنية ليلى مراد “إحنا الاثنين” (أنا وانت يا حبيبي)، توظيفًا عبقريًا… حسين يغني للسينما، يعاملها كحبيبة خانته وهجرته رفقة رجل ثري (المشروع الألماني)، فيما ساهم احتفاظ الفيلم بأصوات “الخربشة”، وصوت أنفاس حسين المتعبة، وصوت الماكينات القديمة، في تعزيز واقعية وثقل المشهد، فكان الصوت بطلًا يروي تهالك الزمن.
ويلاحظ المشاهد أن الإضاءة في المشاهد الأولى كانت خافتة، مليئة بالغبار والظلال، ما عكس حالة السُبات التي تعيشها السينما وحميمية علاقة حسين بها، ومع تقدّم الترميم، أصبحت الإضاءة ساطعة، باردة، وكاشفة، ما عكس عري حسين أمام الواقع الجديد الذي لا مكان له فيه.
وكان لافتًا، في ذات الإطار، أنه حين يكون حسين في المشاهد، يسطع الضوء الطبيعي: الشمس، والممرات، وأسطح البيوت، والانعكاسات، وفي ذلك رمزية واضحة مفادها أن الأصالة تأتي من الضوء الطبيعي، لا من الضوء الاصطناعي، أمّا في المكاتب، وغرف الاجتماعات، أو فضاءات النقاش مع الممولين، فالإضاءة باهتة، ومحايدة، ومكتبية… الضوء هنا بلا روح، إنه ضوء السيطرة، لا ضوء الحياة.
وممّا يميز الفيلم الصدق الجارح، بحيث لم يجمّل صورة التعاون الدولي، بل كشف الوجه القبيح للمشاريع الممولة التي قد تدوس على الأفراد المحليين، كما تميّز بالتوثيق النفسي، حيث لم يكتفِ أليكس بكري بتوثيق الحجر، بل وثّق انكسار الروح، فمشهد حسين وهو يبكي أو يشعر بالقهر في حفل الافتتاح اختزل القضية الفلسطينية برمتها (ضياع الوطن والذاكرة)، وهنا تكمن عبقرية “حبيبي حسين”، أي تحويل قصة شخصية بسيطة إلى إسقاط سياسي واجتماعي عميق.
“حبيبي حسين” وثيقة إدانة بصرية، فهو ليس مجرد فيلم وثائقي عن رجل وُضع جانبًا، بل وثيقة عن معركة رمزية كبرى حول من يملك الحق في تشغيل جهاز سرد الحكاية الفلسطينية، ومن يملك إطفاءه، عبر رؤية إخراجية تعتمد على البساطة الشكلية والعُمق الرمزي، حيث يتعامل المخرج مع شخصية حسين ليس فقط موضوعًا وثائقيًا، بل عدسة نقدية تُرى من خلالها علاقة الفلسطيني مع مؤسسات الدعم الأجنبية، والخيارات الاقتصادية المفروضة على الثقافة الفلسطينية.
ضفة ثالثة
مجلة ايليت فوت ارت