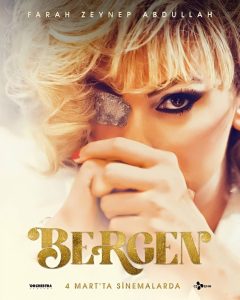ما الذي يجعل ريلكه عظيمًا؟
* ليزلي تشامبرلين
#ترجمة سارة الراجحي
مقتطف من كتاب “ريلكه: الإنسان الجواني الأخير” للكاتبة ليزلي تشامبرلين، الصادر عن دار نشر بوشكين. نُشر في مؤسسة الشعر في ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢.
ليزلي تشامبرلين كاتبة وناقدة بريطانية، كتبت بغزارة عن الأدبين الألماني والروسي. من مؤلفاتها: “باخرة الفلسفة: لينين ومنفى الانتلجنسيا”، و”الفنان السري: قراءة متعمقة لسيجموند فرويد”، و”الوطن الأم: تاريخ فلسفي لروسيا”، و”نيتشه في تورينو”.
لا يمكن إلا أن يكون أمرًا رمزيًا أن نطلق على أحد أعظم شعراء أوروبا في القرن العشرين الرجل الجوّاني الأخير. فبعضنا، ربما في مراحل مختلفة من حياتنا، سيظل منجذبًا دائمًا إلى الصوفي والماورائي. وعلى صعيد آخر، فقد ولى عصر الجوّانية، ذلك العصر الذي ازدهرت فيه في الغرب ثقافاتٌ كانت فردانية وتأملية.
لقد شهد ريلكه نفسه تحولًا جذريًا في توجهه، إذ تضاءلت في زمانه أشكال العبادة الدينية المنظمة، بل والإيمان نفسه، خلال حياته. فهو لم يكن مؤمنًا بالإله قط. ومع ذلك، كانت فكرة الإله، أو بالأحرى الشعور به، تعني له الكثير. وهذا دليل على ما يجعله ليس شاعرًا عظيمًا فحسب بل وشخصية مهمة تاريخيًا.
كانت شهرته في أوجها، في أوائل القرن العشرين، عندما أصبح الزخم الثقافي فجأة علمانيًا وسياسيًا بِشدة. لقد شكّل المستقبل المنغمس في السياسة تحديًا لما ينبغي أن يكون عليه الفن. فجأة بدت “ملائكة” ريلكه و”وروده” عديمة الصلة بالواقع بشكل سخيف. ومع ذلك، يبدو لي إنجاز ريلكه ومكانته أكثر تأثيرًا، بالنظر إليه من هذا المنعطف التاريخي. في عام 1926، عندما مات بعمر 51 عامًا فقط، كان “الجميع” يقرأ رَينير ماريا ريلكه، إذا جاز أن نعني بالجميع الروائية الإنجليزية فرجينيا وولف، مثلًا، والناقد الفني الأمريكي المستقبلي ماير شابيرو، الذي قام برحلته الأولى إلى أوروبا حاملا كتابة ريلكه في جيبه. وكان الروائي النمساوي الحداثي روبرت موزيل معجبا كبيرًا آخر، بينما في فرنسا كان كلٌّ من أندريه جيد، الروائي المرهف الذي علق بين الباطنية الدينية واللاَأخلاقية النيتشوية، وبول فاليري، شاعر الحداثة ذو التعقيد المماثل، قد التقيا ريلكه ومنحاه تقديرًا فنيًا رفيعًا.
أشاد مُوزيل بثراء ريلكه اللغوي في خطاب تأبيني مطول في عام 1927. لكن بعد عشر سنوات فقط في الأوساط الناطقة بالألمانية، وبعد ذلك بقليل في بريطانيا، مع اندلاع الحرب، لم يعد ريلكه ذا أهمية. فَضّل نقاد الطليعة الألمان خيال كافكا، الشاعر الذي يكتب نوعًا جديدًا من النثر، وبريخت، الشاعر الذي أراد تغيير العالم من خلال تَثوير المسرح الدرامي. من السهل معرفة السبب فقد كان ريلكه شديد الانتقاء حيث ناشد أقلية متعلمة. على العكس من ذلك، كان بريخت على وشك نقل القصيدة الغنائية، ومفهوم المسرح ذاته، على أمل مخاطبة جموع الناس. كانت مهمته الترحيب بهم وبِخبراتهم، وبلغتهم، الأكثر خشونة ونَهما وتلقائية في التيار الثقافي السائد.
في هذه الأثناء، لامست أمثال كافكا عن أساليب السلطة الغامضة نوعًا جديدًا من التجارب السياسية. هكذا وجد الرجل العادي المرتبك نفسه في مواجهة سلطات “عليا” مخيفة. كان ضغط السلطة موجودًا دائمًا لكنه كان عَصي الاستيعاب لدرجة أنه ظل بلا مسمى. ستتكرر الإحالات السياسية إلى كافكا طوال القرن العشرين الشمولي، بينما قيل أن ريلكه لم يكن سياسيًا على الإطلاق. وكان هذا صحيحًا، لكن ذلك لم يكن، كما سنرى، القصة بأكملها.
في غضون ذلك، أتساءل عما إذا كان أية سيرة لفنان عظيم تقرأ في بلدان عديدة وتَستوعبه ثقافات مختلفة يمكن أن تكون يومًا قصة كاملة. فقد كانت لكلٍّ من ألْمانيا-النمسا، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية توقيتاتها الزمنية الخاصة مع ريلكه خلال القرن الماضي. وفي ذلك السياق بدا أن القراء الأمريكيين أحبوا ريلكه بلا انقطاع، لأنه منحهم نقد مؤثر عن وتيرة الحياة الصناعية ونمطها، التي لولا ذلك لم يكن يتحملوها غالبا. لقد منح ريلكه، وما يزال يمنح، وظيفة للشعر لمساعدة أي وكل منا تحمل الهجوم المادي التكنولوجي، فهو حصن دنيوي روحاني لكنه ليس ديني، الأمر الذي يزداد ندرة هذه الأيام.
عَكَس التوقيت الزمني الأوروبي كيف أصبح التأثير الروحاني بالِ بشكل سريع، في ظل اجتياح الحَرب والأزمات السياسية للقارة. حَدَّث الشعر نفسه جذريًا وأصبح متورطًا اجتماعيًا بشكل كبير في الثلاثينيات المشحونة سياسيًا، وخاصة في ألمانيا، بعد الهزيمة أمام إنجلترا، والتضخم المفرط، وصعود القومية والقوى العاملة المنظمة. ولحقت إنجلترا بذلك، ولكن على نحو متقطّع، وبفارق عقدٍ زمني، ولم تكن أبدًا بنفس الإصرار. ومع ذلك، كان كل هذا مع سرعة التغيير ثورة، وشكل من وجهة نظرنا هنا ثورة في طريقة الإحساس بالأشياء وتٌقييمها. كان لهذه الثورة الجديدة علاقة بكل ما يعنيه “الحديث” والحداثة” في الأدب.
تلك الظواهر الثقافية -لأنها كانت أكثر ظواهر من كونها منظمة بوعي- كان لها بدورها أسباب أخرى أيضًا. قبل عقدين أو ثلاثة عقود، وفوق كل ذلك، كانت هناك ثورة جمالية، التقط منها أوسكار وايلد وهنري جيمس الإطار الخارجي، التي تأثر بها ريلكه أيضا، بل إنه كان الأقرب لمحور الحركة، فقد كان يقود التغيير الذي وُجد في الطريقة التي كتب بها.
كان ريلكه ذاتيا. أراد أن يخبر العالم عن مشاعره الداخلية وعن مدى صعوبة أن يجد لنفسه موضعًا في هذا العالم. بعض هذه الصعوبات مرتبطًا ببداية القرن العشرين، والطَريقة ذاتها التي سجل بها جُوانيته، عكست حاجته إلى أن يجد أسلوبًا جديدًا يقول به كم كان قَلِقًا. ومع ذلك، في نفس الوقت، لم يغادر القرن التاسع عشر وهدوءه كليا –والأدب الألماني الإقليمي- تمامًا. وسأحكي كثيرَا عن “الفن” في هذا الكتاب. لا يعجبني تعبير “الفنون” لأنه مفهوم تجاري وسلعِي. وهذا هو المسار الذي يأخذه الفن لأنّ الفنانين عليهم أن يعيشوا، ولأنّ الأشخاص القادرين على دفع ثمنه، والكثير منهم لا يستطيع، فهم يريدون الفن في حياتهم ويجدون الطريقة لشرائه أو استعارته أو سرقته. لكنني هنا، أقول إن ما يرغبونه -وما أرغبه أنا- هو الفن، لا “الفنون”. إنه احتياج عظيم. وفي الوقت نفسه، فإنّ الكلمة، المضلِّلة إلى حدٍّ ما في الإنجليزية، لا تعني الرسم فقط. فكلما استخدمتُ كلمة “فن” فإنني أقصد كل ما يشمله المصطلح الألماني die Kunst الذي يتضمن الموسيقى، النحت، الشعر، الدراما (وكان من الممكن أن يشمل السينما، لولا أنّ زمن ريلكه وتجربته كانا مبكرين بالنسبة للسينما). تربط فكرة الفن كل هذه الأنشطة الإبداعية معًا في استجابة راقية وعميقة لما هو إنساني.
قد تكون الطبيعة جميلة بلا حدود، ودرامية، وجذابة، وسامية. يمكننا قراءة رسائل عديدة في الطبيعة. لكنها لا تستطيع أبدًا أن تنتج، من تلقاء نفسها، ما يقدمه الفن والفنانين لنا، ما يعني، تسجيل كيفية اصطدام الحياة المحيطة بنا وتحفيز مخيلتنا. خذ الموسيقى على سبيل المثال. تقدم الموسيقى الكلاسيكية مثالًا رائعًا على ما كان عليه الفن في نِمسا وألمانيا في عهد ريلكه في بداية القرن العشرين. فرغم احتجاج الجمهور، بدت موسيقى شوينبيرج اللاَلحنية وكأنها تُعبّر عن الواقع التكنولوجي الحديث. كانت مثيرة، محيرة، لكنها أيضًا مكررة وتبدو غير منتهية على الإطلاق. فجأة لم يعرف القلب العاطفي الإنساني إلى أين يلجأ -ولعل الجواب الضمني كان: اللامكان، وواجه الحداثة، التي إلى حد ما هي نوع جديد من الكآبة والقساوة، كُشفت بعصر الآلات ولم تختبئ بعيدًا.
كان أسلوب تأليف الرومانسي الجديد الذي سبق شوينبيرج مختلفًا بعض الشيء. التقط شوينبيرج نفسه نهاية هذه الحركة، ولهذا يُفضل العديد من المستمعين الرومانسيين الخامات الثرية، لكن التي لا تزال لحنية، في أعماله الأولى. شخصيًا أحب أن أنْغمس في الرباعية الوترية الأولى في المصنف دي الصغير، والعثور على موطن هناك- ذلك النوع من “الموطن الروحاني” الذي غالبًا ما يلمح ريلكه إليه، ويعني به موطن في الخيال. وكان من بين الرومانسيين الجدد مؤلفون مثل براهمْس وهوجو ولف العاطفي بشدة، التي أشارت تآلف ألحانهم المشحونة عاطفيًا والمتنافرة إلى مسارات خروج من القرن التاسع عشر. لكنهم لم يُجبروا التقليد الغربي الراسخ على إعادة اختراع نفسه، كما فعل شوينبيرج، ربما كان ذلك مؤسفًا، لكنه كان ضروريًا، بعدما خلّف ورائه العمل السابع كان شُونبيرج المبكر في المرحلة البينية، حيث أظن بقوة أنه المكان الذي يجب علينا أيضا وضع ريلكه فيه، أي بين هاتين اللحظتين في الموسيقى، أي، اللحظات الأخيرة من الرومانسية الأخيرة وعلامات القطيعة الأولى.
كانت قصائد ريلكه ذات الإحساس الفردي العميق جديدة وفريدة من نوعها، سواء في غِنائياته الفردية المكثّفة أو في “قصائد الأشياء” التي كتبها، وكذلك في مراثيه وسونيتاته؛ ومع ذلك لا تزال ممكنة الاستيعاب ضمن ما سبقها بقرون من قبله. لكن وصف ريلكه بالمحافظ والجمالي صرف الانتباه تحديدًا عما جعله جديدًا. فالعالم الذي تناوله كان يفقد روحانيته، وكما شعر شوينبيرج بأن الموسيقى تحتاج إلى لغة جديدة، تساءل ريلكه عمّا إذا كان بوسع اللغة القديمة أن تستمر: عمّا يمكن أن تشير إليه وما يمكن أن تعنيه، في وقت كانت فيه مرجعيات مثل الله والروح تفقد مصداقيتها. عمل ريلكه بتجارب جسدية محدودة. واتسمت حياته ببُعدٍ ضيق. لكن قصائده تطورت إلى أسئلة كبرى ولد في براج، في 1875، وعاش في ميونيخ، سافر إلى إيطاليا قبل انتهاء القرن التاسع عشر بقليل. في روما وفلورنسا بدأ اختبار إيمانه العلماني بالتراث الإنساني العظيم. ذهب إلى روسيا، وقضى عام في شمال الريف الألماني، وانتقل، في 1902، إلى باريس.
كان مقيّدًا بالبقاء في ميونيخ أثناء الحرب العظمى، ولم يَعُد كثير الترحال بعدها، وقَبِل بامتنان ملاذًا في سويسرا اشتُري باسمه في سنواته الخمس الأخيرة. وحين توفي عام 1926 متأثرًا باللوكيميا، بعد أن عانى آلامًا مروّعة خلال العامين الأخيرين، كان شعره جديدًا مبهرًا للأعداد المتزايدة من قرائه ولا يزال يغطي المساحات نفسها التي شغلته منذ شبابه.
وهكذا نمضي، ذهابًا وعودة، بشكل جانبي نحو العصر الجديد، ما جعل ريلكه مبدعا هو الكيفية التي استجاب بها لسلسلة بيئاته المحدودة. فقد كان يستمتع بالطبيعة وأعمال الفن في كل مكان، والعيش مع الحيوانات والطيور والأشجار تحت السماوات المظلمة والمضيئة. كان حضور الرياح والنجوم والأتربة قويًا، لكن البشر كانوا نادرين نسبيًا فقد رآهم كغرباء، غالبًا، من مسافة، على الرغم من وجود عدد قليل من الناس الذين عرفهم ودرسهم وتذكرهم جيدًا في عدد قليل من قصائده المميزة. وفي الوقت نفسه أحب الألوان والكاتدرائيات والنحت اليوناني وألعاب الأطفال الدوّارة والأزهار ولاحظهم.
استحضرت اثنان من أشهر قصائده نبات الهيدرانجيا والورد، ومثل فان جوخ، كان مفتونا بأشكال الحياة الجميلة سابقًا -وأبرزها الأزهار، التي بدأت تتناقص. قضى شهور من العزلة برعاية بعض منازل الأسر الصغيرة حيث كانت الطبقة الأرستقراطية الأوروبية بأكملها -الألْمانية والدنماركية والبوهيمية- في حالة تدهور.
سواء قرأناه في الألمانية الأصلية، أو إذا ما ذهبنا إليه كَريلكه الإنجليزي، أو ريلكه الفرنسي، أو ريلكه الياباني، أو قرأناه بلغة برايل، فإنه شاعر عظيم، لما في لغته من موسيقى، وانْشغالاته التي تربطه بفنانين آخرين، وعصره. لكن ما الذي جعله عظيمًا حقًا؟ فمن المؤكد أن العظمة لم تكن مجرد نوع من الارتباط بالواقع أو الملاءمة؟ لأُكرر السؤال وأتوقع الإجابة التي يمنحها هذا الكتاب، أود القول أنه كان يحاول العثور على حساسية للقرن العشرين، في زمن لم تخلق فيه بنية فلسفية معينة بعد قد جعلت سؤال “معنى الحياة” يبدو سُؤالأ ساذجًا.
انشغلت قصائده بجِندرنا وجِنسانيتنا، الإحساس بما يجب أن نفعله بحياتنا، إمكانية تواجد الإله، العلاقة الساحرة بالحيوانات التي تجلب لنا السعادة، أهمية الطفولة، جاذبية الأشياء المادية التي نصنعها ونبيعها ونختار أن نعيش بينها، المشاهد الطبيعية التي نستجيب لها، الكتب التي نقرأها واللوحات التي نحيا بصحبتها. ما من موضوع في نظر رِيلكه قاوم التحول إلى سمة من سمات الكون الساحر الذي يحتوينا في عالم قد يتركنا خلافًا لذلك قلقين وخائفين، فقد كانت هوية الإنسانية الوجودية لغز محير. لم يبحث ريلكه عن تعريف، بل عن أماكن وفصول تُمكّنه من التعبير عنه. لذا فتتبع الحياة اليومية بعينيه هي تجربة فاتنة، عبر الحديقة وطوال الشارع، ومن حين لآخر في مشهد طبيعي أكثر غرابة. لم يكن سعيه بحثًا عن موقع مراقبة، وإنما عن مجاز. يمكنه تحويل أي شيء، متى وُجد المجاز، فهو لا يحتاج إلى إلهام رومانسي مبتذل ليُسحر قُرائه.
في مرثية دوينو العاشرة، على سبيل المثال، ذكر أنواع الأماكن البشرية المتكررة: “Stelle, Siedlung, Lager, Boden, Wohnort”، ويمكننا في الحال استشعار شيء مميز عن أنفسنا في هذه القائمة الشبيهة بالموسوعة. كل من هذه الكلمات الألمانية الخمس هي تقريب أو وجه من أوجه شيء نشعر به بالفعل كل يوم. وبما أنّها يمكن أن تعني جميعًا، بشكلٍ أو بآخر،” مكان للعيش” فيبرز السؤال: أين نحن؟ أين نسكن؟ ماذا ندعو المنزل، ولأي سبب؟ تتبعها أسئلة أخرى. على سبيل المثال: في أي مكانٍ نُزهِر ونُثمِر قبل أن نذبُل نحن أيضًا، كالزهور، ونسقط؟ أين نغرس أنفسنا؟ وأين نزدهر؟ فالنُضج هو أحد انشغالات ريلكه أيضًا، تمامًا كما التدهور والضعف.
تختلف كيفية ترجمة سلسلة الأماكن هذه. إنه “مكان ومسكن ومخيم وأرض ووطن” بالنسبة إلى فيتا وإدوارد ساكفيل ويست، أول المترجمين للمرثيات، “مكان واستقرار، أساس وأرض ووطن” للمترجم المعاصر المتميز ستيفان ميتشيل “أرض، مكان، قرية، مخزن، وطن” لدى الرحّالة المتفرّد، والمهووس أحيانًا، بتراث ريلكه ويليام جاس. لكن النقطة الأساسية، مهما بلغت دقة ترجمة النص الأصلي، فإن جميع أنواع الأماكن تعنينا: موقعنا الجغرافي، المكان الذي استقْررنا فيه مع الآخرين، المكان الذي اخترناه للراحة، حيث ولدنا، وما هو عنواننا الحالي.
إضافة المشاهد الطبيعية: الجبال، الوديان، المروج والجداول ونهر النيل، جسر “بوينتي نويفو” في مدينة روندا الإسبانية، والبركان القديم. ومشاهد المدن: أماكن التسوق ومكاتب البريد. كل هذه المواقع تبين لنا سمة من سمات وجودنا الإنساني لمساعدتنا على تخمين ماذا نفعل هنا، على هذه الأرض، فيما يسميه ريلكه بشكل غير مباشر فضاء Weltraum، أدبيًا يعني المساحة التي يشغلها عالمنا؛ وإن كان يعني أيضًا، بالمعنى المتداول، الكون. بالنسبة لي الترجمة الصحيحة للكلمة، أو بالأحرى استحضار الفكرة، ستكون بعض الأحيان” المكان” و”الزمان”.
بحلول عام 1899، أصبح بمنتصف العمر وسط أهم علاقة حب في حياته، وتحقيق أول نجاح أدبي عظيم، كان ريلكه واعيًا جيدًا بالضُغوط الواقعة على المفهوم المثالي للإنسانية. فقد كانت مهمة جيله الذي لا يزال مسيحيًا ظاهريًا هي الرد بشكل حاسم على داروين. وانطلاقًا من هذا التحدي المتمثل في تطور الإنسانية بدلاً من خلقها إلهياً، أعرب ريلكه في بعض الأحيان عن رغبته في دراسة علم الأحياء. أخذ فصلا دراسيا في ميونيخ في لحظة انتقال القرن. لكنه على الأغلب قرأ وارتجل القليل.
النقطة المهمة أنه انجرف في الهجوم العلماني الكبير الذي أعقب انهيار الرواية التوراتية للماضي. فقد بدأ ذلك الانهيار بفعل أدلة مقنعة أثبتت أن خلق العالم لم يكن بفعل قوّةٍ تُسمى الإله وفق خطةٍ غيبية يُزعَم صلاحُها وعقلانيتها المتعالية وهي مزاعم طالما أقلقت النقّاد، وأرقت المتألّمين. كان التطور رغم إمكانيته أن يشمل الإله، أكثر منطقية وأكثر إقناعًا. وهكذا، ومن دون أن يصرّح حرفيًا، سَجّل ريلكه (ضمِنًا) أفول فكرة الله.
لكنه مثل نيتشه كان منشغلاً بشكل جذري بالبحث عن “بدائل فائقة الوفرة” عن العزاء الماورائي الذي فقد مصداقيته، مستمتعًا بها حتى مع تلاشِيها. كانت روح نيتشه روح فريدة الاستقلال في الفكر والعبارة. وبالمثل، سعى ريلكه إلى البحث عن تلك البدائل بلغته الألمانية الغنية بشكل مذهل -التي لم تكن باهتة على الإطلاق وإنما كانت نابضة بالحياة.
شَعرتُ بالانجذاب إلى ريلكه معظم حياتي تحديدًا لأنه في وجوده لا يزال الفن قادرًا على الوقوف في وجه احتضار القدرة على التأمل الروحي. لكنني تعلمت الاقتراب منه الآن مع بعض التحفظ. وصف ثيودور أدورنو -الناقد الذي أصر في عام 1936 على أن المستقبل لكافكا وليس لريلكه- حياة ريلكه الداخلية بأنها هروب خبيث يعوق الوعي السياسي. كان أدورنو أيضًا الناقد الذي أعلن بعد 15 عامًا أن “كتابة الشعر بعد الأُوشفيتز يعد أمرًا همجيًا”.
ومع ذلك يبدو واضحًا أن أعظم شعراء الهولوكوست، بول كلين، مثل ريلكه، الكاتبً الناطق بالألمانية من ركن آخر في الإمبراطورية النمساوية التي لم تعد موجودة، قد تأثر بعمق باستحضار ريلكه لمادية جميع الأشياء الإنسانية. بالنسبة لكلين، في ضوء الشر البشري كانت مادة البناء الأخلاقي الوحيدة المتبقية هي اللغة المنسوجة حول الأشياء الأرضية. علاوة على ذلك، من أين تعلم شاعر يهودي-ألماني في سنوات ما بعد الحرب تلك الصنعة اللغوية، ومن أين وجد رؤيةً تضاهيها في القوة إلا من ريلكه؟ لقد فهم كلا الشاعرين: أنه إذا كان هناك قوة من الخير التي تظهر من خلال خلق الأعمال الفنية، فهذا ما يدفعنا إلى الوصول إلى الكلمات الصحيحة بالترتيب الصحيح لمنح هذا الخير بعض التأثير الهش على الحياة. لنأخذ نقدا آخر عن “جوانية” ريلكه في زمنه نفسه: قال الفيلسوف لودفيج فيتجنشتاين أن ريلكه كان سامًا. ومع ذلك يكفي أن نتعمق قليلًا في حياة فيتجنشتاين الخاصة لمعرفة أنه كان يصارع أيضًا طبيعته الاستبطانية والاكتئابية، وبالتأكيد، بطريقة ما لا واعية وعميقة، ما جعله لا يريد أن يتم تذكيره بها في الشعر الذي يقرأه.
كان فيتجنشتاين معتمدًا على موهبته الفلسفية للإحساس بحياته مثل اعتماد ريلكه على الشعر، ولديه خوف مماثل من الخسارة. من ناحية أخرى كان فيتجنشتاين منغمسًا في جُوانَِيته من خلال حبه للموسيقى: القيمة الفلسفية الإشكالية الوحيدة لأنه لا يمكن التعبير عنها، لذا أصر في أعماله المتأخرة على افتقار الحياة الداخلية للقيمة. ريلكه -ولست أول من فكر بهذا- من المحتمل أنه ربما قد وُهب لنا لمساعدتنا على فهم فيتجنشتاين. تركيز فيتجنشتاين المحدد كان عن كيفية استخدام اللغة لإنتاج مفاهيم عن الحقيقة والتواصل مع بعضنا بعضا، وقد ساعدني على تخيل أن لغة فيتجنشتاين كانت مصنعًا، مثل المصانع الحديثة المحيطة به في زمنه، وما تم تصنيعه كان المعنى، المتعة وإمكانية التوافق، جنبا إلى جنب الحيرة. انغمس ريلكه في هذه الأثناء في عالم المدن والطبيعة، مكاتب البريد، الحدائق، وألعاب الأطفال الدوارة، وما فعله هو مشاهدته كيف ينسج البشر ويصنعون العالم الذي يستخدمونه.
لم يصل الخلاف مع ريلكه إلى ذروته بين الرجلين. فهما لم يلتقيا أبدا، لكنهما لو فعلا ذلك، وحضر ناقد كوسيط بينهما، هو أو هي، يود إقناع الفيلسوف بأن شعر ريلكه هو الفن، وليس استمرارية للمَاورائية بمعنى آخر. كان الأمر يتعلق بكيفية وجودنا في العالم: كيف نَستخدم أدواته لنسج معانٍ مؤقتة فالكلمات وحدها لا تكفي. علينا أن نواصل ربطها بالأشياء التي يمكن أن تشير إليها، من خلال استمتاعنا واْستنارتنا وتواصلنا مع بعضنا البعض. هناك علاقة واضحة بما كان يفعله فيتجنشتاين، لكن فيتجنشتاين بقي داخل شبكة من الكلمات، بينما بحث ريلكه عن نتيجة ملموسة. أعني بهذا الشعر الذي يتحدث عن وإلى وجودنا المادي، وهو، في رأيي، أكثر إرضاءً من فلسفة اللغة التي تجردنا من المتعة، فالدِقة ليست القيمة الوحيدة المرتبطة بالتواصل الإنساني. صور ريلكه علاقتنا بالحديد والحجارة وقال على سبيل المثال أن هذا ما نحن عليه، منغمسون في عالمنا المادي. ربما لهذا نحن لا نحتاج إلى المزيد مما يعرفه هذا العمود الحجري، بعد أن عانى عبر آلاف السنين.
منغمسون في المواد، مستقرين تحت السماء، نعيش حياة يومية، نحتمي ونبني. وبطبيعة الحال، لا يكفي ذلك في عصر العلم؛ في العصر الحديث. ومع ذلك، انطلاقًا من الجدار والعمود، والبيت والنمر، والملك وعمل الفن، نحن نعيش في حالة من الحضور الفاعل المتزامن، وهذه أيضًا هي حالة وجودنا، إلى جانب السعي إلى المعرفة. أحيانًا يجد ريلكه حقيقة تلك الحالة الوجودية مخيفة (schrecklich)، لكنها غالبا ما تكون أيضًا مدهشة.
_________
Boring Books#
#مجلة ايليت فوتو ارت